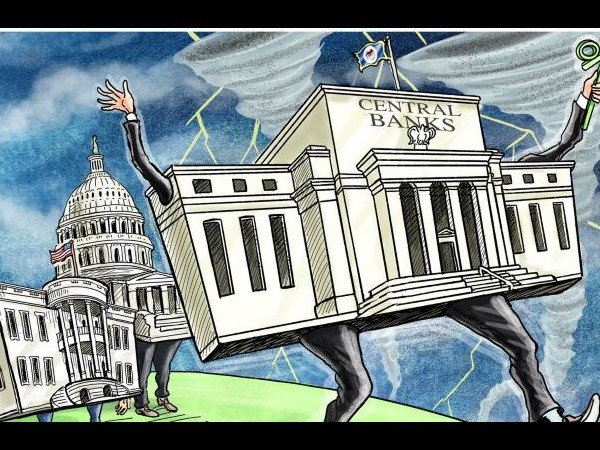جمهورية مصر العربية
- جمهورية مصر العربية -
- الرئيسية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

سجل بياناتك الان
- بواسطة المجلة
- February 25, 2026
مقدمة في النظام المحاسبي الموحد
مقدمة في النظام المحاسبي الموحد اولاً نشاة النظام المحاسبي الموحد عند صدور الاشتراكية عام 1961 والتي ترتب عليها تأميم الكثير من الشركات وضمها إلى الدولة ، وضمن البرنامج الاقتصادي الشامل الذي تبنته الدولة عام 1991 ومن اهمها خصخصة شركات القطاع العام وذلك لزيادة الانتاجية ورفع الدعم المقدم من الدولة ، صدر النظام المحاسبي الموحد عام 1966 بالقرار الجمهوري رقم 4723لسنة 1966 وطبق بهدف توفير البيانات الاساسية والادوات التحليلية اللازمة للتخطيط والتنفيذ والرقابة وتسهيل عمليات جمع المعلومات المحاسبية وتبوبيها وتخزينها واشتمل ايضا النظام المحاسبي الموحد السنة المالية والدليل المحاسبي والقوائم الختامية . ثم في بداية التسعينات وتبني الدولة البرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي كان ابرز ما فيه هي خصخصة شركات القطاع العام والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي حيث تغيرت بيئة الاعمال التي من اجلها إنشا النظام المحاسبي الموحد ومن هنا تطلب إعادة النظر في النظام لم يتلائم والتعديلات الجديدة بحيث يكون قادر على تلبية وتوفير البيانات التالية :- توفير البيانات الملائمة للوفاء بإحتياجات المستثمرين والدئنين وكل من يستخدم القوائم المالية لمساعدتهم في غتخاذ القرارات . توفير المعلومات التي تساعد متخذي القرارات في التنبؤ بمقدار التدفقات النقدية المتوقعة وتوقيت الحصول عليها . توفير المعلومات التي تحتاج إليها الشركات القابضة لمساعدتها في القيام بدورها الاشرافي على الشركات التابعة لها . توفير المعلومات لتحديد مساهمة الوحدات الاقتصادية العامة في المتغيرات القومية . وعليه تم إصدار تعديلات من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تهدف إلى تلافي بعض اوجه القصور في النظام المحاسبي الموحد بما يضمن تلبية الطلبات التي المشار إليها . مفهوم النظام المحاسبي الموحد هو مجموعة من الاسس والقواعد المحاسبية التي تحكم تسجيل وتبويب وتلخيص البيانات المحاسبية في الوخدات الاقتصادية العامة ، وتحليل وتفسير النتائج التي تعبر عنه المركز المالية والحسابات الختامية لمساعدة متخذي القرارات . أهداف النظام المحاسبي الموحد توفير البيانات الاساسية والادوات التحليلية اللازمة للتخطيط ولتنفيذ والرقابة على مختلف المستويات . توفير البيانات اللازمة لاعداد الحسابات القومية . تسهيل عملية تجميع البيانات المحاسبية وتخزينها وتبويبها . الدليل المحاسبي الموحد الدليل المحاسبي هو احد الركائز لاي نظام محاسبي ويتضمن الدليل كافة البنود والعناصر التي تكون موجوده في الوحدة الاقتصادية ويتم تبيوبها وفقا لتجانسها وتم تقسيم هذه المجموعات إلى أربع أقسام لكم منها رقم وهذا ما يعرف بالترميز الرقمي الاصول = 1 حقوق الملكية والالتزامات = 2 التكاليف والمصروفات = 3 الإيرادات = 4 ومن ثم يتم إضافة أرقام تتابعية لكل عنصر من العناصر اعلاه بحيث يعتبر مستوى رقمين على الحساب العام وثلاثة ارقام على الحساب المساعد واربعة ارقام على الحساب الفرعي وخمسة أرقام على الحساب الجزئي وستة ارقام على الحساب التحليلي . وايضا تنقسم الحسابات ضمن النظام المحاسبي الموحد إلى قسمين هما حسابات المركز المالي : وهي كل الحسابات التي تتعلق بإعداد المكز المالي مثل الاصول وحقوق الملكية والالتزمات . حسابات النتيجية : وهي الحسابات التي تتعلق بقياس نتيجة الاعمال مثل التكاليف والمصروفات والايرادات أولا الاصول الاصول طويلة الاجل ( 11 ) أصول ثابته ( 12 ) مشروعات تحت التنفيذ (13) إستثمارات طويلة الاجل (14) قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل (15)أصول اخرى الاصول المتداولة (16) مخزون (17)عملاء واروراق قبض (18) إستثمارات مالية متداولة (19) نقدية بالبنوك والصندوق ثانياً : حقوق الملكية والالتزامات حقوق الملكية (21)رأس المالي المدفوع (22) الاحتياطيات (23) الاربح ( الخسائر ) المرحلة (24) ( أسهم خزينة ) (25)التزامات طويلة الاجل الالتزامات المتداولة (26) مخصصات (27) بنوك دائنة (28) موردون واوراق دفع وحسابات دائنة . ثالثاً : التكاليف والمصروفات (31) خامات ومواد ووقود وقطع غيار . (32)اجور (33) مصروفات
- بواسطة المجلة
- February 25, 2026
جامعة القاهرة التعليم المفتوح كود 432 الفرقة الرابعة : المحاسبة عن الموارد الذاتية للبنوك التجارية
جامعة القاهرة التعليم المفتوح كود 432 الفرقة الرابعة : المحاسبة عن الموارد الذاتية للبنوك التجارية الموارد الخاصة بالبنوك التجارية هي موارد ذاتية دخلية وموارد خارجية أما عن الموارد الداخلية فهي رأس المال والاحتياطيات والارباح المرحلة وهو ما يطلق عليه حقوق الملكية . أما عن الموارد الخارجية فهي التي يحصل عليها مقابل أنشطتة وتقديم خدماته المصرفية من ودائع بانواعها , الموارد الذاتية الداخلية للبنك التجاري أولاً : رأس المال المدفوع هو القيمة الاسمية لاسهم رأس المال المدفوع من قبل المساهمين وطبقاً لقانون رقم 163 لعام 1957 يجب الا يقل رأس المال عن مائة مليون دنية ورأس المال المدفوع عن خمسين مليون جنية ، اما عن أفرع البنوك الاجنبية يجب الا يقل المال المخصص لنشاطها عن خمسة عشر مليون دولار امريكي أو ما يعادلة بالعملات الحرة . ثانياً : الاحتياطيات " المبالغ المحتجزة " هي مبالغ تستقطع من الارباح السنوية بغية عدم التوزيع وذلك لاغراض معينة من أمثلتها :- الاحتياطي القانويني حيث يجنب من صافي الربح 5% على الاقل لتكوين إحتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير مراقبي الحسابات وقف تجنب الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال . كما يجوز إستخدم هذا الاحتياطي لتغطية خسائر البنك الاحتياطي الخاص : وفقاً لتعليمات البنك المركزي لا يجوز التصرف في رصيد هذا الاحتياطي الابعد الرجوع للبنك المركزي . الاحتياطيات الاخرى : مثل الاحتياطي العام لشراء سندات حكومية وإحتياطيات أرتفاع أسعار أصول ثابتة والاحتياطيات التدعيمي والاحتياطي الرأسمالي ، ومنها ما يكون إجباري العمل على تكوينها ومنها ما يكون إختياري الدوافع التي وراء التقييد جزء من الارباح في شكل إحتياطي - إعتبارات قانونية حيث تفرض التشريعات المختلفة ضرورة خصم نسبة معينة من الارباح السنوية الاتقل عن 5% في شكل إحتياطيات قانونية وغيره وذلك لاهداف إقتصادية ومنها دعم المركز المالي. - لمجابهة بعض الخسائر المحتملة في فترات مالية أخرى . - إعتبارات تعاقدية كما في حالة طلب المقرضون تقييد توزيع الارباح أو جزء منها خلال فترة سريان القروض بما يدعم المركز المالي . ثالثاً : الارباح المرحلة وهي الارباح الفائضة يتم ترحيلها إلى فترات لاحقة وغالباً ما يكون الهدف منها هو تمهد الدخل بمعني أن مصلحة الإدارة أن تكون التوزيعات السنوية على المساهمين أو الملاك غير متباينة من فترة إلى فترة أخرى وذلك للحفاظ على مستوى التوزيع المعتاد للارباح سنوياً المعالجة المحاسبية لعمليات حقوق المساهمين من تلك العمليات 1- عمليات أصدار الاسهم . 2- عمليات تخصيص جزء من الارباح في شكل إحتياطيات . 3- عمليات توزيع الارباح . قيود عمليات إصدار الاسهم بعد الموافقة على تأسيس البنك ووفقاً لرأس المال المحدد حسب القوانيين المعمول بها يتم الترخيص له بإصدار عدد محدد من الاسهم وبناء عليه توجد مفاهيم متعددة لرأس مال الاسهم . - رأس المال المرخص به : هو بعيد عن الحد الاقصى للاسهم المصرح بإصدارها بالنسبة للبنك ومعنى ذلك إمكانية عدم التقيد بإصدار كل الاسهم المصرح بها وبالتالي لا يعد عملية الترخيص بالاصدار عملية واجبة الاثبات بالسجلات . - رأس المال المصدر : وهو عدد الاسهم الذي قام البنك بإصدارها فعلا وهو يساوي أو يقل عن عدد أسهم رأس المال المرخص به . - رأس المال المدفوع : وهو بمثابة الجزء المدفوع من رأس المال المصدر والذي يحسب بالمعادلة التالية رأس المال المدفوع = عدد الاسهم المكتتب فيها X القيمة المدفوعة للسهم - رأس المال الاضافي المدفوع : وهو حساب وسيط يتم إستخدمة لمعالجة فروق المبالغ المحصلة عن قيمة الاسهم المكتتب بها ويلاحظ أن جملة رأس المال المدفوع بالميزانية تشير إلى حساب رأس مال الاسهم مضافاً إليه حساب رأس المال الاضافي . عند إصدار الاسهم بالقيمة الاسمية المحصل قيمتها دفعة واحدة يجري القيد التالي من حـــ / النقدية إلى حـــ / رأس مال الاسهم " القيمة الاسمية المكتتب فيها والمحصلة دفعة واحدة " عند إصدار الاسهم بعلاوة إصدار والمحصل قيمتها دفعة واحدة من حـــ / النقدية إلى مذكورين حـــ / رأس مال الاسهم " القيمة الاسمية " حـــ / رأس المال الاضافي " علاوة الاصدار " عند إصدار الاسهم وتحصيل قيمتها على دفعات من حـــ / النقدية إلى حـــ / قسط الاكتتاب عند إجراء تخصيص الاسهم من حـــ / قسط الاكتتاب إلى حـــ / رأس مال الاسهم عند طلب القسط الثاني من حـــ / القسط الثاني إلى حـــ / رأس مال الاسهم عند تحصيل القسط الثاني من حـــ / النقدية إلى حـــ / القسط الثاني حقوق المساهمين رأس المال المدفوع xx إحتياطيات xx أرباح محتجزة xx إجمالي حقوق المساهمين xx لا يظهر في العرض السابق البند الخاص برأس المال الاضافي المدفوع " علاوة الاصدار " حيث تسير التعليمات على النمط التقليدي في المعالجة المحاسبة لعلاوة الاصدار عن طريق تعليقها على حساب الاحتياطي . حــ / علاوة الاصدار إلى حــ / الاحتياطي القانوني عمليات تخصيص جزء من الارباح في شكل إحتياطي إثبات ترحيث صافي أرباح العام القابل للتوزيعات من حـــ / الارباح والخسائر إلى حــ / الارباح المحتجزة إثبات ترحيل الارباح والخسائر المحتجزة في اول السنة المالية في حال وجود أرباح مرحلة من حـــ / أرباح مرحلة إلى حـــ / أرباح محتجزة في حال وجود خسائر مرحلة من حـــ / أرباح محتجزة إلى حـــ / خسائر مرحلة إثبات قرار التخصيص من حـــ / الارباح المحتجزة إلى حـــ / الاحتياطي القانوني إلى حـــ / إحتياطي عام إلى حـــ / إحتياطي خاص إلى حـــ / إحتياطيات أخرى إلى حـــ / توزيعات مساهمين إلى حـــ / حصص عاملين إلى حـــ / مكافآت أعضاء مجلس الادارة حيث يكون رصيد هذه الحسابات معبراً عن الارباح والخسائر المرحلة نهاية الفترة والتي تظهر بدورها في قائمة المركز المالي تحت مسمى أرباح وخسائر محتجزة ويمكن النظر لهذا الرصيد بإعتبارة حلقة الوصل بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي حيث يعكس نتائج كافة الاحداث . عمليات توزيع الارباح توزيعات الارباح والتوزيعات النقدية هي السبب الرئيسي وراء قرار الاستثمار في الاسهم وتوزيعات الارباح قد تأخذ شكل نقد أو أسهم كمنحة . توزيعات الارباح النقدية عند صدور قرار بتوزيع الارباح النقدية للمساهمين من حــ / الارباح المحتجزة إلى حــ / توزيعات أرباح نقدية مستحقة عند سداد قيمة التوزيعات النقدية من حــ / توزيعات أرباح نقدية مستحقة إلى حــ / النقدية توزيعات الأسهم قد توزع الاسهم على شكل منح أو توزع نقدي عند صدور قرار توزيع أسهم كمنحة من حــ / الارباح المحتجزة إلى مذكورين حــ / أسهم منحة تقرير توزيعات حــ / رأس المال الاضافي المدفوع " علاوة أصدار " عند صدور شهادات أسهم كمنحة من حــ / أسهم منحة تقرير توزيعات إلى حــ / رأس مال الاسهم
- بواسطة المجلة
- February 25, 2026
GPS للمحاسب : دليل وأفكار للوصول إلى الهدف
GPS للمحاسب: دليل وأفكار للوصول إلى الهدف في عالم يتسارع فيه التغيير، يحتاج المحاسب إلى أدوات تساعده على تحديد موقعه الحالي، رؤية الوجهة المستقبلية، ورسم الطريق الأكثر كفاءة للوصول إلى الأهداف. هنا يأتي مفهوم GPS للمحاسب كمصدر إلهام للتخطيط المالي وتنظيم العمليات المحاسبية. في هذا المقال، سنستعرض كيف يمكن للمحاسب أن يتبنى نموذج GPS للوصول إلى أهدافه الشخصية والمهنية، مع تقديم أفكار إبداعية تجعل من هذا المفهوم أداة لا غنى عنها. ما هو GPS للمحاسب؟ GPS (Global Positioning System) هو نظام موجه يعمل على تحديد الموقع الحالي والوجهة المطلوبة ورسم أفضل مسار للوصول إليها. بنفس الطريقة، يمكن أن يكون GPS للمحاسب هو نظام شخصي أو مهني قائم على: تحديد الوضع الحالي: تقييم دقيق للمهارات، الموارد، والوضع المالي. تحديد الهدف: وضع أهداف محددة قابلة للقياس. التخطيط للوصول: رسم مسار واضح يعتمد على خطوات تدريجية. أهمية استخدام GPS للمحاسب التخطيط الفعّال: يساعد المحاسب على توجيه جهوده نحو ما هو مهم فعلاً. تحقيق التركيز: يمنع التشتت بين الأهداف المختلفة. التكيف مع المتغيرات: يمكن للمحاسب تعديل مساره بناءً على المعطيات المستجدة. كيف يمكن للمحاسب تفعيل GPS الخاص به؟ تحديد الموقع الحالي: أين أنا الآن؟ قبل التوجه نحو أي هدف، يجب أن يعرف المحاسب موقعه الحالي، ويتحقق ذلك عبر: تحليل المهارات: ما الذي أجيده؟ وما هي المهارات التي أحتاج إلى تطويرها؟ فهم الوضع المالي: سواء كان للشركة التي أعمل بها أو لحسابي الشخصي، يجب إعداد تقارير واضحة تظهر الإيرادات، النفقات، والمخاطر. تقييم الأداء السابق: مراجعة القرارات المالية والمحاسبية التي تم اتخاذها سابقًا، وما إذا كانت ناجحة أم تحتاج إلى تحسين. تحديد الوجهة: ما هو هدفي؟ كل رحلة تحتاج إلى وجهة. يمكن للمحاسب تحديد أهدافه بناءً على: أهداف مهنية: الحصول على شهادة مهنية مثل CPA أو CMA، أو الترقية إلى منصب مالي أعلى. أهداف شخصية: تحسين التوازن بين العمل والحياة، أو تحقيق استقرار مالي شخصي. أهداف للشركة: زيادة الأرباح، تحسين التدفقات النقدية، أو تقليل النفقات. رسم الطريق: كيف أصل إلى هناك؟ لتحقيق الأهداف، يجب وضع خطة محكمة تشمل: تحديد الأولويات: ما هي الخطوات الأهم والأكثر تأثيرًا؟ تخصيص الموارد: الوقت، المال، والجهد يجب أن يُستخدم بحكمة لتحقيق الهدف. التعلم والتطوير: إذا كانت المهارات الحالية غير كافية، يجب وضع خطة للتطوير من خلال الدورات التدريبية، القراءة، أو الاستعانة بالخبراء. استخدام التكنولوجيا: برامج المحاسبة الحديثة مثل Odoo أو QuickBooks يمكن أن تسهل العمليات وتوفر الوقت. مراقبة التقدم: هل أنا على الطريق الصحيح؟ مثلما يقوم GPS بإعادة توجيهك إذا انحرفت عن المسار، يجب على المحاسب مراقبة التقدم وتقييم النتائج باستمرار: مراجعة الأداء بشكل دوري: مقارنة ما تم تحقيقه بالأهداف الموضوعة. إجراء تعديلات: إذا واجهت تحديات غير متوقعة، قم بتعديل الخطة للوصول إلى الهدف. التعلم من الأخطاء: الاستفادة من التجارب السابقة لتجنبها في المستقبل. أفكار إبداعية لتطبيق GPS للمحاسب لوحة قيادة شخصية (Dashboard) صمم لوحة معلومات تحتوي على الأهداف، المؤشرات الرئيسية (KPIs)، والتقدم المحرز. يمكن أن تكون هذه اللوحة ورقية أو باستخدام تطبيقات مثل Trello أو Notion. خطة تعليمية موجهة أنشئ خريطة تعليمية مثل GPS تحتوي على المحطات (الدورات التدريبية أو الشهادات)، والتوقيت المتوقع لإنجاز كل محطة. إدارة الوقت بفعالية خصص وقتًا يوميًا أو أسبوعيًا لمراجعة التقدم نحو الهدف. استخدم تطبيقات إدارة الوقت مثل Toggl لتتبع كيفية استغلال وقتك. التحفيز الذاتي تمامًا مثل الرحلة الطويلة التي تحتاج إلى محطات استراحة، كافئ نفسك عند تحقيق إنجازات صغيرة. التفكير الاستباقي استخدم البيانات المتاحة لتحليل الاتجاهات المستقبلية. مثلاً، إذا كنت تعمل في شركة، توقع التحديات المحتملة مثل انخفاض الطلب أو زيادات التكاليف، واستعد لها مسبقًا. قصص نجاح: GPS في الحياة العملية شركة ناشئة تتحول إلى ربحية بدأ محاسب في شركة ناشئة بوضع خريطة مالية تشمل تحليل التكاليف، زيادة الإيرادات، واستهداف شرائح عملاء جديدة. خلال عام، تحولت الشركة من الخسارة إلى تحقيق أرباح مستدامة. تطوير محاسب مهنياً محاسب طموح حدد هدفه بالحصول على شهادة CMA خلال سنتين. باستخدام خطة GPS، وزع وقته بين العمل والدراسة، واستطاع اجتياز الاختبارات بنجاح وحقق قفزة في مسيرته المهنية. ختامًا: كن قائد رحلتك المالية GPS للمحاسب ليس مجرد أداة، بل هو أسلوب تفكير يساعدك على التركيز على ما يهم، التخطيط بذكاء، وتحقيق أهدافك بكفاءة. سواء كنت تسعى لتطوير مهاراتك، تحسين وضعك المالي، أو تحقيق أهداف شركتك، يمكنك استخدام هذا المفهوم لتصبح قائدًا ماليًا محترفًا ومؤثرًا. تذكر دائمًا: النجاح رحلة تحتاج إلى خطة واضحة، مراقبة مستمرة، ومرونة للتكيف مع المتغيرات. اجعل من GPS دليلك، وانطلق بثقة نحو أهدافك! ???? المصدر : مجلة المحاسب العربي GPS #للمحاسب #دليل_المحاسب_المالي #التخطيط_المالي #أفكار_للمحاسب #تحقيق_الأهداف_المالية #إدارة_الموارد المالية #استراتيجيات_المحاسب_الناجح #تطوير_المحاسب_المهني #أدوات_المحاسب_المبتكرة #تحسين_الأداء المالي #التوازن_بين_العمل_والحياة_للمحاسب #أهداف_المحاسب_المستقبلية #دور_المحاسب_في_الإدارة #نظام GPS في التخطيط المالي #مهارات_المحاسب_الحديثة #تحديات_المحاسب_المهنية #استخدام_التكنولوجيا_في_المحاسبة #خريطة_المحاسب_لتحقيق_الأهداف #مهام_المحاسب_الناجح #كيفية_رسم_الطريق_المالي
- بواسطة المجلة
- February 25, 2026
جامعة القاهرة التعليم المفتوح كود 432 الفرقة الرابعة : طبيعة الجهاز المصرفي
الاحتياطي القانوني لابد لنا بداية من بيان أنواع الاحتياطي، خاصة مع ظهور العديد من التقسيمات لهذه الأنواع، والتي حددت أنواع الاحتياطي بأشكال متعددة وفقاً للزاوية التي ينظر فيها وكالآتي: أولاً. من حيث درجة الالتزام ويقسم إلى: 1. احتياطي الزامي: وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركة. 2. احتياطي حر: وهو الاحتياطي الذي يترك امر تكوينه إلى الهيئة العامة. ثانياً. من حيث مصدر الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياجات إيرادية: ومصدرها الأرباح الاعتيادية الناتجة عن النشاط العادي للشركة([1]). 2. احتياطيات رأسمالية: ومصدرها أرباح الشركة غير العادية وتمتاز هذه الأرباح بأنها غير دورية وليس لها صفة الانتظام وغير مرتبطة بنشاط الشركة، وغير متكررة كعلاوة إصدار الأسهم والسندات أو إعادة تقييم الموجودات أو بيع الموجودات الثابتة([2]). ثالثاً. من حيث الهدف من تكوين الاحتياطيات ويقسم إلى: 1. احتياطيات تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة. 2. احتياطيات تهدف إلى تنفيذ سياسات إدارية أو مالية معينة. 3. احتياطيات تهدف إلى المساعدة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية([3]). رابعاً. من حيث ظهورها في قائمة المركز المالي وتقسم إلى: 1. احتياطيات ظاهرة: وهي التي يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية. 2. احتياطيات سرية: وهي التي لا يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية وتتكون أما بقصد أو بدون قصد([4]). وسأكتفي ببيان الاحتياطيات الآتية لإجماع التشريعات عليها وهي: 1. الاحتياطي القانوني. 2. الاحتياطي النظامي. 3. الاحتياطي الحر. 4.الاحتياطي المستتر([5]). وسأكتفي ببيان الاحتياطي القانوني في هذا المطلب، ونخصص المطلب الاخر للاحتياطيات الأخرى. الاحتياطي القانوني: ويقصد به الاحتياطي الذي ينص على وجوب تكوينه صراحة في قانون الشركات([6])، ويحتل هذا النوع اهمية بالغة لانه بمثابة ضمان لدائني الشركة فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته القانونية لانه مخصص اساساً لتكملته وجبره إذا اصيب بخسارة، استناداً إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه ارباحاً في السنوات التي لا تسفر عن أرباح([7]) وقد اجتمعت القوانين على وجوب تكوينه ولكنها اختلفت في: أ. نسبة الاستقطاع. ب. مدى استخدامه. نص قانون الشركات العراقي في المادة (73) على وجوب استقطاع ما لا يقل عن 5% من الربح الصافي، لتكوين هذا الاحتياطي إلى ان يصل رصيده إلى خمسين في المائة 50% من رأس المال المدفوع حيث حدد الحد الأدنى للاستقطاع وأجاز الاستمرار في الاستقطاع إلى ان يصل إلى خمسين في المائة من رأس المال، وأجاز الاستمرار إلى أن يصل مئة في المئة 100% من راس المال بموافقة الهيئة العامة. وبينت المادة (74) استخدامات هذا الاحتياطي كما يأتي: 1. توسيع أعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال. 2. الاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة. 3. الإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية. 4. والمهمة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة منه 50%، وما زاد عن هذه النسبة يكون خاضعاً لموافقة المسجل والجهة القطاعية. كما أعطى المشرع الحق للجهة القطاعية بتوجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي وبما يخدم الأغراض المذكورة. لقد انفرد المشرع العراقي بإباحة استخدام هذا الاحتياطي للأغراض أعلاه، وهو موقف يتسم بالمرونة في التعامل مع هذا الاحتياطي، وباعتقادنا ان حكمة المشرع تقوم على أساس توظيف الأموال المتراكمة في رصيده، وحسناً فعل المشرع عندما أعطى للجهة القطاعية الحق في توجيه الشركات وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأغراض وذلك من خلال الرقابة التي تمارسها على الشركات([8])، والجهة القطاعية المختصة ملزمة بحضور اجتماعات الهيئة العامة وبنفس الوقت ترسل اليها الحسابات الختامية للشركة التي يظهر فيها – في التقرير الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الشركة- رصيد الاحتياطي واستخدامه([9]). أما من الناحية العملية، وبعد الاطلاع على الوثائق المالية لبعض الشركات تبين ان الشركات تثبت مقدار هذا الاحتياطي كرصيد يظهر في الحسابات الختامية ويدقق من ناحيتين، الاولى ان الاستقطاع لم يتجاوز نسبة خمسة في المئة 5% من الربح الصافي، على الرغم من ان المشرع حدد الحد الأدنى وهذا يعني انه يمكن ان تكون اكثر، ومن الناحية الثانية لا يتجاوز الرصيد المتجمع خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع وقد يصل مئة في مئة 100% منه دون القيام باستخدامه في حدود هذه الأغراض، ولدى الاستفسار من دائرة تسجيل الشركات([10]) في وزارة التجارة حول عدم تنفيذ هذا الاستخدام، كانت الإجابة انهم يؤكدون على هذه الاستخدامات وخصوصاً فيما يخص تحسين ظروف العمل والعمال، كبناء مساكن وشقق لهم أو تحسين مستواهم الاجتماعي أو تهيئة برامج ترفيهية لهم لغرض زيادة الإنتاجية، وان عدم الاستخدام يرجع إلى تخوف الشركات من استخدام هذا الاحتياطي. اما الشركات فتعزو عدم الاستخدام إلى عدم تشجيع مسجل الشركات والرغبة في الإبقاء على الرصيد ثابتاً واستخدمه في إطفاء الخسائر فقط، وحتى في هذا المجال (أي إطفاء الخسائر) لاحظنا عند الاطلاع على ميزانية بعض الشركات أنها تستخدم الفائض المتراكم في إطفاء خسائرها وبعلم من مسجل الشركات([11])، وهنا يظهر تساؤل: من المسؤول عن عدم استخدام الشركات للاحتياطي القانوني ؟ وهل هو مجرد رصيد يصل إلى خمسين في المئة 50% من رأس المال أو مئة من مئة 100% فقط ؟، ويبقى مجرد رصيد ضخم يبلغ الملايين([12]). لم يبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتياطي عن الخمسين في المئة 50%، كذلك لم يبين كيفية إعادة تكوين هذا الاحتياطي بعد استخدامه وبالنسبة المحددة قانوناً أو ما زاد عنها وبموافقة المسجل والجهة القطاعية، لان الشركة بهذه الحالة تكون قد استخدمت اكثر من نصف رصيدها لهذا الاحتياطي، ولم يبين طريق التسديد ولم يحدد سقف زمني لهذا التسديد، وقد ترك مسجل الشركات الحرية للشركة في استكمال رصيد هذا الاحتياطي([13]). كذلك لم توضح المادة (74) الفقرة (2) المقصود بكلمة (منه) عندما نصت على (اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز 50% منه وما زاد عن ذلك يتم بموافقة المسجل والهيئة القطاعية) فهل المقصود راس المال أي اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من راس المال؟ أو المقصود إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني؟ وباعتقادنا ان المقصود وهو خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني، والحكمة التي يستند عليها هذا التقييد هو اخذ المشرع بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي وهو الدفاع عن راس المال وابقائه ثابتاً، ومما يؤكد هذا ان مسجل الشركات يؤيد موقف الشركات التي لجأت إلى فائضها المتراكم في إطفاء خسائرها دون الاستعانة باحتياطيها القانوني لاداء مهمته الأساسية. وقد ذهب رأي في الفقه ان المقصود هو إطفاء الخسائر وبما لا يتجاوز خمسين من المئة من راس المال …)([14]) وباعتقادنا ان هذا التفسير ليس صحيحاً، كما ان الشركة إذا بلغت خسارتها 50% من راس مالها وجب عليها ابلاغ المسجل وهو بدوره يبلغ الجهة القطاعية لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة بهذا الشأن([15]). وكان الافضل لو تمت صياغة المادة (74) الفقرة (2) على النحو الآتي (إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين من المئة 50% من رصيد الاحتياطي القانوني…). ويؤيد جانب من الفقه القانوني العراقي نسبة استقطاع هذا الاحتياطي([16]) وهو رأي جدير بالتأييد، ونحن نؤيد موقف المشرع العراقي بتحديد السقف الاعلى لهذا الاحتياطي، وذلك لتجنب تجميد هذا الرصيد دون استثمار أو استغلال([17]). فلا يعقل ان يبقى حجم كبير من الأموال دون استثمار لان المال (النقد) عقيم أي لا يولد مالاً الا من خلال الاستثمار وخاصة ونحن نعيش في اقتصاد يعاني من حالة التضخم الجامح بسبب الحصار الجائر المفروض علينا لذا نرى ان هذه النسبة ملائمة وهي 5% وكذلك وضع الحد الأعلى لرصيد هذا الاحتياطي([18]). وكذلك يحمد موقف المشرع باعطائه الخيار للهيئة العامة بين الاكتفاء بترصيد هذا الاحتياطي إذا بلغ خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع أو الاستمرار لحد مئة في المئة 100% منه. وباعتقادنا انه اعطاها الحق بتقدير النسبة الكافية لهذا الاحتياطي وبما يتناسب مع راس مالها الاسمي، ومن الافضل إعطاء الهيئة العامة الحق باستخدام هذه النسبة (أي 50%) لتأمين الحد الأدنى من الأرباح واستخدامها في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية، فهذه الزيادة تتحقق بناء على قرارها([19]). وكذلك إعطاء الهيئة العامة الحق في دمج هذه النسبة براس المال عندما ترغب الشركة بزيادة راس مالها([20])، فالشركات تلجأ إلى هذه الزيادة عندما ترغب بالتوسع في نشاطها أو خسارتها، وفي الحالة الأولى تكون الشركة مخيرة بين الأخذ من مصدر تمويلها الذاتي أو استخدام الطرق الأخرى في الزيادة، وباعتقادنا ان اعتماد الشركة على احتياطيها في زيادة راس مالها هو افضل للأسباب الآتية: 1. الحيلولة دون ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها على نحو يعيق تداولها، فالشركة التي لها احتياطيات كبيرة ترتفع أسعار أسهمها في السوق المالية وبالتالي يصعب تداول الأسهم. 2. زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام يستلزم نفقات باهظة يمكن تجنبها إذا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى راس المال([21]). أما في الحالة الثانية وهي تعرض الشركة للخسارة فسيكون للشركة الاعتماد على مصدر تمويلها الذاتي (وهو دمج الاحتياطي القانوني في راس المال) بدلاً من اللجوء إلى طرح اسهم جديدة للاكتتاب لأنه من الصعوبة بمكان إقبال الجمهور على الاكتتاب باسهم شركة تعرضت للخسارة([22]) على الرغم من ان المشرع العراقي جعله أحد البدائل في سبيل معالجة خسارة الشركة([23]). أما قانون الشركات المصري فقد الزم بتجنيب جزء من عشرين أي (5%) في الأقل من الأرباح الصافية، وأعطى أيضاً الحق للجمعية العامة بوقف هذا الاستقطاع إذا بلغ رصيد هذا الاحتياطي ما يساوي نصف راس المال المصدر وحصر استخدامه في إطفاء الخسائر، وفي زيادة راس المال المصدر بدمجه به بقرار من مجلس الإدارة([24]). أما القانون الأردني فقد نص في المادة (186) من قانون الشركات على استقطاع ما نسبته 10% من أرباحها الصافية إلى ان يبلغ المتجمع ما يعادل ربع راس المال المصرح به، وأجاز للهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع إلى ان يبلغ كامل راس المال المصرح به، واجاز استخدامه في جبر الخسائر فقط([25]). وحدد المشرع الإماراتي في المادة (192) من قانون الشركات اقتطاع 10% من صافي الربح ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. وباعتقادنا ان النسبة المذكورة في القانون هي الحد الأدنى لهذا الاستقطاع، وللجمعية العامة التوقف عنه متى بلغ هذا الاحتياطي نصف راس المال المدفوع، وأجاز استعمال ما زاد على نصف راس المال في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة([26]). أما المشرع الإنكليزي فلم يلزم الشركات بتكوين احتياطي قانوني بل ترك تكوين الاحتياطيات لمجلس المديرين وذلك في المادة (110) من القانون. كما نص في المادة (264/2) على عدم جواز توزيع أرباح من بعض الاحتياطيات في حالة منع القانون ذلك. ([1]) ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية في الشركة الخاصة وموقف المشرع العراقي منها، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، عدد (21)، سنة 1987. وينظر نفس المعنى مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([2]) ويرى بعض المحاسبين ان المبالغ التي يتكون منها هذا الاحتياطي لا توزع أرباحاً على المساهمين، والحكمة في هذا ان ما يتحقق من أرباح متصلة بالموجودات أو المطلوبات الثابتة لا ينبغي النظر إليه على انه قابل للتوزيع الا في حالة تصفية الشركة، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. وأما علاوة الإصدار فموقف القوانين منها ما يأتي: . اعتبر المشرع العراقي في المادة (31) علاوة الإصدار هي الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم لتغطية نفقات الإصدار والباقي يسجل في حساب احتياطي باسمها ولم يجوز توزيع أرباح منها. اما المشرع المصري وفي المادة (31) من قانون الشركات فقد أوجب إضافتها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ما يساوي نصف راس المال المصدر، اما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيكون منها احتياطي خاص، وباقتراح من مجلس الادارة ان يقرروا في شأنه ما يحقق مصلحة الشركة ولا توزع أرباح منه، المادة (94) من اللائحة التنفذية لقانون الشركات المصري، والمشرع الاردني في المادة (113) من قانون الشركات اجاز ضم (الاحتياطي أو الارباح المتراكمة أو كليهما. وعلاوة الاصدار إلى رأس مال الشركة عند زيادته وبنفس الوقت وجوب توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يمتلكه من اسهم)، ونصت على جواز رسملة علاوة الاصدار المادة (14) من تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها نقلاً عن د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص332، اما المشرع الاماراتي، فقد اجاز اضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز نصف رأس المال المدفوع، المادة (203) من قانون== ==الشركات الإماراتي، نص القانون الإنكليزي للشركات في المادة (130) استخدام احتياطي علاوة الإصدار في دفع قيمة الأسهم الموزعة مجاناً (اسهم المنحة) على أعضاء الشركة تعتبر كأنها مدفوعة بالكامل، أو تغطية نفقات التاسيس، أو تغطية نفقات العمولة أو الخصم الخاص بإصدار أي اسهم أو سندات للشركة. ونلاحظ ان القوانين تكاد تتفق على عدم إجراء توزيعات للربح منها، كونها لا تنتج عن نشاط الشركة العادي، ويرى البعض أنها تلحق بموجودات الشركة وتعتبر نظير اشتراك المساهم الجديد في الأموال الاحتياطية التي تكون لدى الشركة ولم يساهم فيها، د. يوسف يعقوب صرخوة، مصدر سابق، ص185، وهناك من يرى ان الهدف منها تعويض المساهمين القدامى عن الضرر الذي لحق به نتيجة دخول شركاء جدد، د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص709. اما بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية الاخرى (استبدال الموجودات أو بيع الموجودات فهي ترصد لصيانة الموجودات وتجديدها ولا توزع ارباح منها باستثناء القانون المصري فقد جوز المشرع في المادة (40) من قانون الشركات توزيع أرباح ناتجة عن بيع البعض من الموجودات الثابتة الا انه قيد هذا الجواز بالابقاء على اصول الشركة كما كانت. ([3]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، السيد مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21. ([4]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر نفسه، السيد مقبل علي احمد، المصدر نفسه، ص21. ([5]) وقد أضاف الدكتور هاني محمد دويدار احتياطياً اخر اطلق عليه بـ (الاحتياطي الكامن)، ويرتبط تكوينه في المشروعات الانتاجية وذلك عند خصم مخصصات الاندثار (بالنسبة للأصول القابلة للاندثار) من الوعاء الضريبي. وينشأ تكوينه في حالة تأجير هذه الأصول على نحو يسمح بالاندثار بمعدل يختلف عن المعدل الذي تحدده تعليمات الاندثار، فإذا كان معدل الاندثار الذي تحدده هذه التعليمات أسرع من معدل الاندثار الذي تتضمنه الأجرة، فان الشركة المؤجرة يخصم من وعائها الضريبي اكثر من ما يكون لديها من خصوم فعلاً، ويتكون هذا الاحتياطي من الفرق المتحصل من اختلاف معدلي الإهلاك. ويختلف هذا الاحتياطي عن الاحتياطي المستتر بان الأول مشروع بينما الثاني غير مشروع. د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص519. ([6]) نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس المال الشركات المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص76. ([7]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص499، ينظر نفس المعنى د. عزيز العكيلي، الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، ط1، مكتبة المنهل، 1978، ص241. ([8]) نصت المادة (125) من قانون الشركات العراقي (تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في التنمية). ([9]) المادتان (127 و 128) من قانون الشركات العراقي. ([10]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([11]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([12]) دليل المستثمر لعام 2000، الاصدار الخامس لسوق بغداد للأوراق المالية. ([13]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة التسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002. ([14]) فاروق ابراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([15]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([16]) فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42. ([17]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص359. ([18]) وضع الحد الأعلى جاء به قانون الشركات الجديد ذو الرقم (21) لسنة 1997 بينما القانون السابق الملغى ذو الرقم 36 لسنة 1983 لم يكن فيه سقف للتوقف عن الاستقطاع، حيث نصت المادة (73) على استقطاع 5% على الأقل فقط. ([19]) وهذا ما نص عليه قانون الشركات الإماراتي ذو الرقم (8) لسنة 1984 في المادة 192، وكذلك قانون التجارة السوري ذو الرقم (149) لسنة 1943 المعدل في المادة (246) وحدد النسبة المستخدمة بان لا تتجاوز 5%. ([20]) أجاز المشرع المصري في المادة (40) من قانون الشركات المصري استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال المصدر، والزم الشركة بتكوين احتياطي آخر. ([21]) أستاذنا كامل عبد الحسين، مهند إبراهيم، زيادة راس مال الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 2000، العدد (10)، ص44-ص71. ([22]) نغم حنا ننيس، مصدر سابق، ص35. ([23]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي. ([24]) اما زيادة راس المال المرخص به فيتم بقرار من الجمعية العامة غير العادية، المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. ([25]) أجاز القانون الأردني للشركات ذات الامتياز استخدامه كذلك في تأمين الحد الأدنى لنسبة الربح المقرر وفي أي سنة لا تسمح بها أرباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد المقرر. ([26]) وهذا ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة (167) من قانون الشركات وحدد نسبة الاستخدام 5% فقط لتأمين توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة تأمين هذا الحد. وأجاز للهيئة العامة استخدام رصيد هذا الاحتياطي إذا زاد عن نصف مال الشركة في الوجوه التي تراها في صالح الشركة ومساهميها الانترنيت.
- بواسطة المجلة
- February 25, 2026
عامل الزمن من أهم مقومات النجاح
المعنى الحقيقي للنجاح هو أن يحقق الإنسان إنجازا ذا قيمة كبيرة ينقله من واقع إلى واقع أفضل منه بكثير بحيث لا يمكن أن يعود إلى سابق عهده إلا بشكل نادر جدا ، مثل الشاب الذي يتخرج من كلية الطب ويصبح طبيبة ناجحة لا يمكن أن يعود سهم حياته إلى الوراء ويكون ليس طبيبا . والنجاح بصورة عامة ليس بالأمر البسيط كما له آثار إيجابية كثيرة في حياتنا ، والإنسان الماهر المتمكن من عمله سواء كان مهندسا أو إدارية أو رجل أعمال ، وبصرف النظر عن مجال عمله هو أكثر فاعلية وتحكما على زمام حياته من الإنسان البسيط الذي يفتقر إلى مهارات عالية ويعتمد على وظيفة عادية للغاية وقد يسد مكانه أي شخص بسهولة . دل بها على أهوائنا ومخاوفنا ونزوعنا إلى الراحة الجسدية والبقاء في المنطقة الآمنة والإنسان بطبيعته العمل المتعب وارتياد الزوايا المجهولة ولكن في حال امتلكنا رغبة كبيرة في تحقيق هدف معين سوف نتغلب على ذلك ولهذا معظم الناجحين هم أصحاب إرادة قوية . كما نحتاج إلى الطريق المناسب الذي يوصلنا إلى هدفنا المنشود وذلك عن طريق القراءة والاستماع إلى المحاضرات المفيدة والاستفادة من السابقين الذين خاضوا تجربة النجاح في المجال الذي نسعى للنجاح فيه وغيره من المجالات الحيوية . وأول درس ينبغي أن نتعلمه في بداية هذه الرحلة هو أن تدرك جيدا بأن الفرق بين العمل واللعب هو أن العمل يتمثل في أي نشاط يقوم به الإنسان ويعود عليه بالنفع أو على أناس آخرين . والمساهمة في تشييد الحضارات . وسمعت قبل سنوات من أحد الناجحين بأن ٪۸۰ من الأشخاص الذين يعملون ما عليهم فعله ويبذلون الجهد الكافي سوف ينجحون في تحقيق أهدافهم وأثبتت لي الأيام بعد ذلك بشكل ملموس صحة هذه النظرية . ومن عناصر النجاح الأساسية هو الصبر على تحمل الصعاب ؛ لأن حياة البشر لا تسير على وتيرة واحدة وليس كلما نخطط له في عقولنا يتحقق على أرض الواقع بنفس الصورة التي رسمنا لها ، لذلك نحتاج إلى الصبر ونذكر أنفسنا دائما بأهميته . الصبر هو العنصر الأساسي الذي يحتاج إليه الناس في سبيل سعيهم للنجاح ، خط مستقيم ، وإذا لم نمنحها القدر المطلوب من الزمن سنكون من العاجلين ، لهذا في الأدب الروسي يقول العجوز الحكيم للطفل الذي يقود العربة امش رویدا لكي نصل بسرعة . لا يود أن يخسر إطلاقا يريد أن تكون الأمور كلها على ما يرام ، كلها ممهدة أمامه والناس كلهم أخيار وصادقون معه ، أما ماعدا ذلك من الخسائر والإخفاقات المقبولة يكون تجنبها على حساب شجاعتنا في خوض تجربة الحياة بالشكل الذي يتلاءم مع قدراتنا ، عندما تخرج من مرحلة الثانوية التحق بكلية الطب وتخصص في طب العيون وأصبح طبيبة ، وطبعا هذا غير ممكن ولكن بسبب طموحه الكبير ومبادرته وفقه الله في مشروع عالمي استفاد منه آلاف الناس