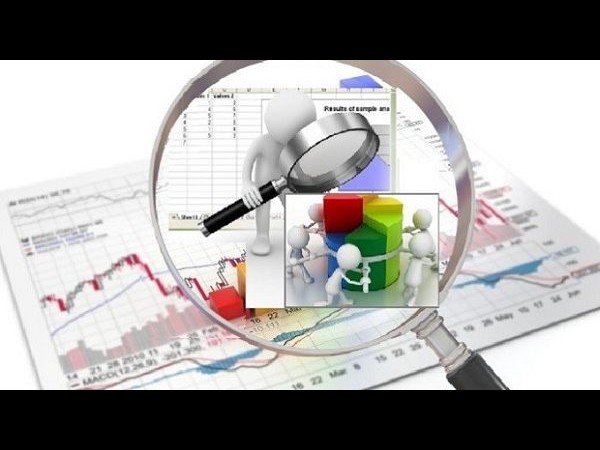المحاسبة المالية
- المحاسبة المالية -
- الرئيسية
- المحاسبة المالية
- المحاسبة الادارية
- محاسبة تكاليف
- التحليل المالي
- الاقتصاد
- بنوك
- محاسبة الضرائب و الزكاة
- المحاسبة الاسلامية
- تطوير المحاسبين
- التأمينات
- قسم تجارة الفوركس
- قسم البرامج المحاسبية
- موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
- المراجعة وتدقيق الحسابات
- القوائم المالية
- دراسات الجدوى
- المحاسبة باللغة الإنجليزية
- المحاسبة الحكومية
- محاسبة الشركات
- إدارة أعمال
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

سجل بياناتك الان
- بواسطة الادمن
- January 12, 2026
مفهوم المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات
مفهوم المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات لطفية فرجاني مقدمة : يسهم نظام المعلومات المحاسبية بصورة إيجابية في تقديم المعلومات المفيدة في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات عن طريق أفراد وجهات داخل المنشأة وخارجها ولكي تحقق المعلومات فوائدها المرجوة ينبغي أن تكون دقيقة وملائمة تقدم في التوقيت المناسب وهذا يعني ضرورة الأخذ بأحداث تقنية مناسبة للمعلومات لذا تستخدم المنشآت الحاسبات الالكترونية في تشغيل بياناتها وذلك لما توفره من سرعة ودقة في تشغيل وتداول تلك البيانات(1) وهذا بالتالي أثر كثيرا في عملية المراجعة حيث نشأت الحاجة للمراجعة الآلية من أجل زيادة درجة الموثوقية في البيانات التي تجعلها أساسا يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرارات . المبحث الأول : ماهية المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات يقصد بالمراجعة في ظل المحاسبة الآلية للمعلومات : هي عملية جمع وتقييم لتحديد فيما إذا كان استخدام الحاسب يساهم في حماية أصول المنشأة ويؤكد سلامة بياناتها ويحقق أهدافها بفاعلية ويستخدم مواردها بكفاءة(2) وبناءً على التعريف السابق فأن هدف المراجعة في ظل المراجعة الآلية للمعلومات يجب أن يتركز على التحقق من وجود :(3) نظم معلومات محاسبية ملاءمة توفر المعلومات لإعداد القوائم و التقارير السليمة بكفاءة عالية . نظام فعال للرقابة الداخلية يمنع حدوث الأخطاء و المخالفات أو يقللها إلى حدها الأدنى . أولا : تكنولوجيا المعلومات وعملية المراجعة : إن عملية المراجعة هي عملية منتظمة للحصول على أدلة تتعلق بتأكيد الإدارة عن البيانات المالية وتقييم هذه الأدلة بصورة موضوعية من أجل التحقق من مدى مطابقة تأكيدات الإدارة للمعايير الموضوعة وتوصيف النتائج للأطراف ذات العلاقة . ولما كانت الموارد المتاحة للمدقق محدودة فإن المدقق مكلف بتوجيه الموارد المحدودة توجيها أفضل لجمع الأدلة التي تمكنه من الخروج بالنتيجة المناسبة لذلك فقد بدأ الاهتمام بدراسة مدى وفعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية المراجعة لمساعدة المراجع في أعمال المراجعة .(1) فالأنظمة الالكترونية لم تغير المناهج والطرائق المحاسبية ولكنها غيرت بصفة أساسية وجوهرية الإجراءات المحاسبية كما أن أهداف المراجعة لم تتغير ولكن الأدوات التي يستخدمها المراجعون لتحقيق هذه الأهداف قد تغيرت .(2) أي أن أهداف المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات لا تختلف عن الأهداف في المراجعة اليدوية من حيث :(3) إبداء الرأي . خدمة الإدارة . وبما أن اصطلاح مراجعة التشغيل الالكتروني للبيانات لوصف نوعين مختلفين من النشاط المرتبط بالحاسب :(4) الأول : عملية فحص وتقويم هيكل الرقابة الداخلية في نظام التشغيل الالكتروني للبيانات . الثاني : استغلال الحاسب من قبل المراجع في أداء بعض أعمال المراجعة والتي كانت تتم بشكل يدوي . فإن جميع عمليات تشغيل البيانات ضمن نظم المعلومات المحاسبية لا بد وأن تخضع إلى نظام الرقابة الداخلية باعتباره جزءا مكملا لنظم المعلومات المحاسبية وبالتالي فإنه يمكن وضع إطار للمراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات وهذا الإطار يتكون من ثلاث مراحل :(5) المرحلة الأولى : فحص نظام الرقابة الداخلية و تخطيط عملية المراجعة تحتوي هذه المرحلة على وضع أهداف المراجعة وأنشطة التخطيط المبدئية و الأنشطة المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات الضرورية التي تسمح للمراجع بعمل تقييم مبدئي واضح ومحدد لنظام الرقابة الداخلية للاعتماد على أساليب الرقابة الداخلية لأوجه النظم اليدوية و الإلكترونية. المرحلة الثانية : أداء عملية المراجعة يرتكز الأداء على خطة المراجعة الموضوعة في المرحلة الأولى وتتضمن هذه المرحلة عمليات جمع البيانات والمعلومات أكثر تفصيلاَ للتأكد من أن أساليب الرقابة اليدوية والإلكترونية تكون دقيقة وتؤدي وظائفها على نحو فعال وتستطيع مساعدة المراجع في تحديد أو تعيين حدوث الأخطاء ونواحي الضعف الجوهرية وهي تمثل بدورها مدخلات اختبارات الوجود وبقية إجراءات المراجعة الأخرى . المرحلة الثالثة : اختبارات الوجود هذه المرحلة تساعد المراجع في الوصول إلى دقة ومعقولية بيانات المفردات المدرجة بالقوائم المالية وترتكز هذه الاختبارات التي يقوم بها المراجع على النتائج التي توصل إليها في المرحلة الأولى و المرحلة الثانية . ويرى الباحث : إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية المراجعة يساهم في توفير أسس أفضل لممارسة الحكم الشخصي من قبل مراجعي الحاسبات كما أنها تساهم في تعليل تكاليف عملية المراجعة مما يؤدي إلى تحسين عملية المراجعة بشكل عام مما يساهم في الارتقاء بالمهنة إلى المستوى الذي تخدم فيه الأطراف المستفيدة على أفضل وجه . ثانيا : أهمية وأهداف المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : أ- أهمية المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : لا يمكن للمراجع أداء مهمته في مراجعة العمليات المحاسبية الالكترونية دون استخدام الحاسوب وذلك للأسباب التالية :(1) التطور المستمر في مهام وإجراءات المراجعة نتيجة التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية . توفير الوقت اللازم لأداء عملية المراجعة لما يترتب عن المراجعة من آثار على المركز المالي للعديد من المنشآت . وبما أن عملية المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات تتطلب بأن يكون لدى المراجع معرفة ودراية بطبيعة النظام الالكتروني فإنه من الأفضل مشاركة المراجع في تصميم جوانب الرقابة والمراجعة حيث أن مشاركة المراجع في تصميم النظام سوف تكون أكثر حساسية وضرورية في حالة نظم التشغيل المتقدمة كما أنها تساهم في تحقيق الأمور التالية :(2) ضمان اكتشاف الأمور الشاذة وتقليل احتمال التحايل والتلاعب بالحاسب الالكتروني نظرا لإمكانية وضع نظم رقابية محاسبية أفضل . تمكن المراجع من استخدام أساليب أفضل لجمع الأدلة والقرائن وتزيد من احتمال اكتشاف الأخطاء والغش . معالجة المشكلات المتعلقة بفقدان الدليل المستندي وعدم توافر مسار للمراجعة . تزويد المراجع بنسخ لكل البرامج المتعلقة بالتطبيقات المحاسبية الهامة والتعديلات فيها . وبالتالي فإن استخدام الحاسوب في مجالات المراجعة المختلفة يساعد في تقليل الوقت المبذول على العمليات الكتابية وعلى العمليات الحسابية وتقليل تكاليف عملية المراجعة بشكل عام وتنبع أهمية استخدامه في مجالات المراجعة في أنه يساعد على تحقيق الأمور التالية :(1) 1- تحسين عملية اتخاذ القرار وعملية ممارسة الحكم الشخصي . 2- تحسين جودة عملية المراجعة بشكل عام . 3- زيادة النظرة المتفائلة لدى العملاء إزاء عملية المراجعة . 4- زيادة شهرة مكاتب المراجعة بسبب استخدامها الحاسوب في عملية المراجعة. 5- الحصول على العملاء جدد نتيجة استخدام الحاسوب في المراجعة . 6- إمكانية استخدام أساليب حديثة في المراجعة بسبب استخدام الحاسوب . 7- إمكانية إنجاز بعض العمليات المراجعة المعقدة بدرجة أكثر سهولة . 8- تسهيل عملية مراجعة أعمال المراجعين من قبل الشركاء أو المديرين . ب- أهداف المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : إن استخدام نظم الحاسوب لإنجاز أعمال المراجعة تسمح للمراجع بالاستفادة من إمكانيات الحاسوب في تنفيذ هذه الأعمال بسرعة وبدقة أكبر حيث تمكنه من استخدام برامج الحاسوب لقراءة البيانات المطلوب التحقق منها واختيار العينات وإجراء الخطوات اللازمة لجمع الأدلة كما تساعده في تنفيذ الاختبارات المنطقية والحسابية وبالتالي سهل الحاسوب للمراجع عملية التحقق من صحة العمليات السابقة وبتكلفة أقل من تكلفة الأداء اليدوي أي أن استخدام الحاسبات الإلكترونية في إدارة البيانات المحاسبية قد أدى أو يساهم في تحقيق الأهداف التالية:(2) الاقتصاد : أي أن هدف المراجع فحص استخدام الحاسوب للتأكد من أنه يستخدم بأقصى طاقة ممكنة لخدمة المنشأة وبأقل التكاليف ويوفر المعلومات والبيانات المطلوبة في الوقت المناسب مما يعود بالمنفعة على المنشأة . الفعالية : أي أن هدف المراجع فحص فعالية الأدوات الرقابية للتأكد من كفاءة نظام الرقابة الداخلية في جميع الأنشطة الإدارية والمالية والتشغيلية . الكفاية : أي أنه يجب على المراجع التحقق من استخدام الحاسوب لتلبية المتطلبات الأكثر أهمية بالنسبة للمنشأة بحسب مفهوم الأهمية النسبية . الحماية : بمعنى أن يتأكد المراجع من حماية النظام من مختلف المخاطر المرافقة لاستخدامه ومن أهمها انهيار النظام وفقدان البيانات المخزنة على الأقراص الحاسبية ومشكلات الفيروسات وسرقة البيانات أو التخريب المتعمد الذي قد تتعرض له النظم لتغطية المخالفات التي قد يرتكبها بعض العاملين . وبما أن جميع عمليات تشغيل البيانات ضمن نظم المعلومات المحاسبية لا بد وأن تخضع إلى نظام الرقابة الداخلية وبما أن نظام الرقابة الداخلية يعتبر جزءا مكملا لنظم المعلومات المحاسبية كما ذكرنا سابقا فإنه يعمل بشكل دقيق على تحقيق الأهداف التي سبق ذكرها لذلك سنعرض بإيجاز الوسائل الرقابية التي يتكون منها نظام الرقابة الداخلية :(1) 1- الرقابة المحاسبية : ويطلق عليها اسم الرقابة الوقائية أو المانعة أو الرقابة قبل الأداء وهي : " الخطة التنظيمية للمنشأة والإجراءات المتبعة والسجلات المستخدمة التي تتعلق بحماية أصول المنشأة والتأكد من صحة البيانات المحاسبية ومدى إمكانية الاعتماد عليها " وتختص الرقابة المحاسبية بتحقيق أهداف حماية الأصول والسجلات وضمان دقة البيانات المحاسبية . 2- الرقابة الإدارية : ويطلق عليها اسم الرقابة بالتغذية المرتجعة أو الرقابة بعد الأداء وهي: " الخطة التنظيمية للمنشأة وكل ما يرتبط بها من إجراءات ومقاييس تتعلق بتفويض سلطة اعتماد العمليات والتي تعتبر من مسؤوليات الإدارة نحو تحقيق أهداف المنشأة وكذلك كنقطة بداية في وضع الرقابة المحاسبية على العمليات " وتختص الرقابة الإدارية بتحقيق أهداف النهوض بالكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة . 3- الضبط الداخلي :(2) وهو مجموعة من الوسائل والمقاييس والأساليب التي تضعها الإدارة بفرض ضبط عمليات المنشأة ومراقبتها بطريقة تلقائية مستمرة وذلك بجعل عمل كل موظف فيها يراجع من قبل موظف آخر مما يساهم في تحقيق رقابة كل شخص على الشخص الذي يليه . ويرى الباحث : أنه من أجل تحقيق أهداف المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات لا بد أن يتأكد المراجع من وجود نظام فعال لرقابة الداخلية يناسب النظم الالكترونية ويوفر خاصة الرقابة الوقائية ( المحاسبية أو الرقابة على الأداء ) التي تمكن من تجنب الكثير من لأخطاء قبل وقوعها . المبحث الثاني : طرق المراجعة ودور المراجع في ظل المعالجة الآلية للمعلومات على الرغم من المزايا الكثيرة التي حصلت عليها المنشآت من استخدام النظم المحاسبية الحديثة إلا أن هذه النظم قد ترافقت مع العديد من المشكلات وذلك نتيجة للأخطاء أو التلاعب أو ضعف نظام الرقابة الداخلية .... الخ وتعتبر مهمة تقويم البيانات أو المعلومات المعالجة حاسبيا جوهر عمل المراجع في بيئة الحاسوب والتي تتطلب الإجابة من خلالها عن التساؤلات التالية : هل تتم عمليات تشغيل البيانات بطريقة توفر المعلومات المطلوبة في الوقت والدقة المناسبين وبشكل اقتصادي ؟ ما مدى مصداقية المعلومات الناتجة عن النظام الحاسوبي ؟(1) للإجابة على هذه التساؤلات لا بد للمراجع من أن يتمتع بالخبرة والمهارة الفنية الكافية لتقويم النظم الحاسوبية . أولا:المراجعة المخططة والمراجعة الفجائية في ظل المعالجة الآلية للمعلومات:(2) تتمثل المراجعة المخططة والمراجعة الفجائية في إتمام إجراءات كل من المراجعة الداخلية والخارجية لذلك نجد في أغلب الأحيان أن المراجعة المخططة تحتاج إلى تخطيط مسبق من خلال التنسيق بين الأطراف المختلفة وكذلك أخطار إدارات الفروع لتوفير المستندات الأصلية اللازمة لعملية المراجعة وكذلك تحديد الوقت اللازم من الحاسوب لفحص البرامج والملفات وما إلى ذلك وهذا النوع من المراجعة يتطلب جدول معين . بينما المراجعة الفجائية فهي عملية فحص غير مجدولة حيث يسيطر المراجع على كافة عمليات المنشأة بهدف التحقق من سلامة ودقة عمليات معالجة البيانات ولذلك تفيد المراجعة الفجائية في تحقيق ما يلي : أ- توفير الفرصة للمراجع لفحص عمليات المنشأة خلال ظروف يأمل أن تكون عادية وعلى هذا الأساس يتوقع أن تمثل البيانات بأمانة المدخلات اليومية وبالتالي يكون لدى المدقق تصور جيد عن الإجراءات الجاري إتباعها . ب-عدم إعطاء الفرصة للمتلاعبين لإخفاء اختلاساتهم والتي تعتبر ذات أهمية بالغة في ضبط عمليات الغش المنظم في معالجة البيانات. ولنجاح المراجعة المخططة والمراجعة الفجائية فإن ذلك يعتمد على وجود مسار جيد للمراجعة بدءاً من المستندات الأصلية وانتهاء بالإفصاح عن البيانات في التقارير المالية . ويرى الباحث : أن أهمية مسار المراجعة تنبع من أنه كان مرئيا في ظل المعالجة اليدوية للبيانات المحاسبية ومن السهل تتبعه أما عند استخدام الحاسب في معالجة البيانات أصبح غير مرئي ومن الصعب تتبعه وخاصة إن مسار المراجعة يعتبر من أهم وسائل الرقابة المحاسبية ( الرقابة الوقائية ) . ثانيا : دور المراجع في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : ينص المعيار ( 401 ) الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين على ما يلي : " على المراجع أن يتمتع بالمعرفة الكافية بأسلوب عمل نظم المعلومات الحاسوبية بهدف تخطيط وإدارة ومعاينة الأعمال المنفذة وعليه أن يقرر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى الاستعانة بمهارات متخصصة في مجال نظم المعلومات الحاسوبية "(1) وقد يكون من الضروري استعانة المنشأة بأخصائيين في مراجعة عمليات التشغيل بالحاسب خاصة في ظل التعقيدات الكبيرة المتعلقة بنظم التشغيل المباشر فضلاً عن الخطر المقترن بتلف وتدمير الملفات أثناء الاختبار لذلك فإن من أهم السمات التي تكون مطلوبة ويجب أن تتوافر لدى المراجع في ظل البيئة الإلكترونية تتمثل في :(2) 1- غريزة المراجعة . 2- الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة . 3- الخبرة في الصناعة والإدارة . 4- الخبرة والإلمام بنظام التشغيل الإلكتروني للبيانات المحاسبية. وحسما للجدل حول المهارة الفنية المطلوب توفرها لدى المراجع فقد أوصى مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي ( AICPA ) بأن تتوفر كحد أدنى لدى المراجع الكفاءات التالية :(3) 1- معرفة أساسية نظم الحاسوب ومكوناتها ووظائفها وإمكانياتها التشغيلية . 2- المقدرة على التصميم وإنشاء خرائط لتدفق النظم الحاسوبية وتحليلها للتعرف على مواطن القوة والضعف في هذه النظم . 3- خبرة عامة بلغات البرمجة تسمح له بكتابة برامج بسيطة الإلمام بأساليب المراجعة في بيئة الحاسوب . ومن الواضح أنه لا بد للمراجع من أن يتمتع بالكفاءة الفنية اللازمة لإنجاز أعمال المراجعة حيث أن خبرة وكفاءة المراجع بالنظم الالكترونية تساعده في القيام بالخطوات التالية التي تساعده على جمع الأدلة في بيئة الحاسوب :(1) جمع البيانات المراد تحليلها . 2- معالجة البيانات اللازمة لإنشاء أدلة الإثبات المؤيدة . 3- استخراج وطباعة نتائج الخطوتين السابقتين . ما من ناحية المسؤولية التي تقع على عاتق المراجع اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب تتمثل في نشر معايير المراجعة رقم ( 20 ) والتي أصدرها مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي والتي تختص بمسؤولية المراجع عن تحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك مسؤوليته عن التقرير عن ذلك إلى الإدارة وذلك من خلال النص التالي :(2) (( يجب على المراجع أن يبلغ كلاً من الإدارة العليا للمنشأة ومجلس إدارتها بأي مواطن ضعف جوهرية في نظم الرقابة الداخلية أثناء عمليات فحص التقارير المالية و التي لم يتم معالجتها أو تصحيحها قبل فحصها ويفضل أن تتسم الاتصالات بين المراجع والمنشأة محل المراجعة في صورة تقرير مكتوب حتى يمكن تفادي احتمال سوء الفهم وإذا اكتفى المراجع بتبليغ المسؤولين بالمنشأة شفويا ًفعليه أن يشير إلى ذلك بكتابة ملحوظة في أوراق عمل المراجعة )) . ويرى الباحث : أنه لا بد إجراء تخطيط لعملية المراجعة مذلك لأن التخطيط يزود البرامج بإطار عام عن الأداء المتوقع ونطاق عملية المراجعة . كما أن عملية المرجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات تتطلب أن يكون المراجع على فهم ودراية بطبيعة النظام الالكتروني على المراجعة لذلك لا بد من تحديث كوادر المراجعين الحاليين وإعطائهم دورات تكثيفية في نظم المعلومات المحاسبية وذلك لتطوير الأساس العلمي والعملي بحيث يناسب بيئة التشغيل الالكترونية أما المراجع فعليه مراقبة التغير وذلك بالعمل على ثقل خبرته في مجال في مراجعة نظم التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية وذلك من خلال التدريب المستمر والإطلاع على الكتب المتخصصة في ذلك . المبحث الثالث : ماهية مخاطر المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات عرفت معايير المراجعة الصادرة عن المنظمات المهنية خطر المراجعة على أنه : فشل المراجع بدون قصد في تعديل رأيه في القوائم المالية بطريقة ملائمة رغم أن هذه القوائم محرفة تحريفا جوهريا .(1) ونظرا للآثار البالغة التي أحدثتها نظم التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية في عملية المراجعة فقد حاز موضوع خطر المراجعة اهتمام العديد من الجهات المهنية وخاصة أن جودة عملية المراجعة ترتبط بدرجة اكتشاف المراجع للأخطاء والغش ( التحريفات ) بأنواعها فكلما زادت جودة عملية المراجعة قل خطر المراجعة وابتعدت عن الغش في اكتشاف الأخطاء مما يعطي الثقة اللازمة للمراجع في إبداء رأيه الفني المحايد في مدى صحة وصدق القوائم المالية المعدة الكترونيا .(2) أولا : مكونات خطر المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : وتتمثل مكونات خطر المراجعة في الخطر الحتمي وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف وفيما يلي نلقي الضوء على هذه المكونات في ظل المعالجة الآلية للمعلومات : 1- الخطر الحتمي : يعتبر الخطر الحتمي من مكونات خطر المراجعة وعوامل أو مؤشرات هذا الخطر لا يمكن تجاوزها عند تخطيط عملية المراجعة ونظرا لهذا الدور فقد عرفت المنظمات المهنية الخطر الحتمي على أنه :(3) " قابلية تعرض رصيد حساب معين أو نوع معين من العمليات لحدوث خطأ جوهري ويكون جوهريا إذا اجتمع مع غيره من الأخطاء في أرصدة الحسابات أو عمليات أخرى وذلك مع عدم وجود إجراءات رقابة داخلية " ولا شك أن نسبة الخطر الحتمي تتأثر بالخصائص الفريدة لطبيعة أعمال المنشأة فضلا عن طبيعة نظام التشغيل الالكتروني المطبق والصعوبات التي يفرضها هذا النظام فيما يتعلق بكيفية مراجعة هذا النظام علاوة على تعقيد أداء عملية المراجعة . فالتعديلات في مسار المراجعة المتعلقة بنظم التشغيل الالكتروني للبيانات تتمثل أساسا في الدليل المستندي للعملية ونظرا لأن المستندات المستخدمة في إدخال البيانات للحاسب قد يحتفظ بها لفترة قصيرة من الوقت أو قد لا توجد مستندات للمدخلات على الإطلاق في بعض نظم المحاسبة الالكترونية نظرا لإدخال البيانات بشكل مباشر إلى النظام لذلك لا بد للمراجع زيارة المنشأة بشكل متكرر أثناء السنة وذلك لفحص المعاملات في الوقت التي ما تزال فيه النسخة المستندية موجودة لدى المنشأة كما يتطلب منه أيضا أداء اختبارات أكثر من أجل تبرير تقدير الخطر الحتمي أقل من المستوى الأقصى .(1) ويرى الباحث : نظرا لمسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء والغش والمخالفات لذلك لا بد للمراجع من تقييم مستوى الخطر الحتمي عند التخطيط لعملية المراجعة مما يزيد من فاعلية قرارات المراجع في اكتشاف تلك الأخطاء والمخالفات التي يؤدي إلى التحريف الجوهري في القوائم المالية . 2- خطر الرقابة : ويعرف خطر الرقابة على أنه :(2) " احتمال عدم منع أو كشف الأخطاء الجوهرية بواسطة هيكل الرقابة الداخلية بالمنشأة وما يحتويه من سياسات وإجراءات " وبما أن هيكل الرقابة الداخلية في ظل المعالجة الآلية للمعلومات يختلف عن هيكل الرقابة الداخلية التي تتم بشكل يدوي فإن تقدير خطر الرقابة يتم وفقا لمناهج مختلفة حيث أن هيكل الرقابة الداخلية الآلية ينطوي على بعض الضوابط الرقابية الأخرى للوقاية ضد نوعين من الأخطار هما :(3) أ- خطر الوصول إلى ملفات البيانات السرية نظرا لإمكانية عدد كبير من الأشخاص الوصول إلى الوحدة المركزية لمعالجة البيانات . ولتفادي سهولة الوصول إلى النظام يخصص رمز أو كلمة سرية لكل شخص مصرح له باستخدام النظام ولتعليل خطر الرقابة المرتبط بهذه النظم فإن الأمر يستوجب : الرقابة الفعالة على كلمات السر . استخدام رموز مركبة من أجل التوصل إلى ملفات البيانات الحساسة ذات الأهمية الكبيرة . تغيير كلمات السر من وقت إلى آخر . يجب توثيق النظم والبرامج والتعديلات فضلا عن التحقق من أن هذه التعديلات قد تم اعتمادها بشكل دقيق . تحديد الاختصاصات والواجبات فيما يتعلق بعناصر قاعدة البيانات . ب- خطر ضياع مسار المراجعة بقصد إخفاء حالات الغش والتلاعب بواسطة المنفذين وذلك من خلال عمليات التحديث الفورية للملفات الرئيسية حيث يتم تحديث الملفات الرئيسية بصفة مستمرة . ولحماية مسار المراجعة من الضياع هناك بعض الضوابط التي تساعد على ذلك ومن أهمها(1) توجيه عناية دقيقة لعملية إعداد المدخلات عند تصميم نظم المعالجة الآلية للمعلومات. تسجيل جميع أنشطة الحاسب في ملف تاريخي . الاحتفاظ بملفات يومية احتياطية من أجل الرجوع إليها وقد تحفظ تلك الملفات على أشرطة أو أقراص ممغنطة . يجب أن تتضمن البرامج المستخدمة في عمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف أو الحماية الذاتية الكافية ضد أي استخدام من شخص غير مصرح له باستخدام هذه البرامج . ويرى الباحث : أنه ينبغي أن يتوافر للمراجع الدراية والفهم لعناصر هيكل الرقابة الداخلية في ظل المعالجة الآلية للمعلومات ( بيئة الرقابة – النظام المحاسبي – الإجراءات الرقابية ) والتي تحدثنا عنها سابقا كما أنه لا بد من التركيز على ما إذا كان هنالك دليل كافي بخصوص قوة وفعالة هيكل الرقابة وذلك من أجل تبرير تقليل خطر الرقابة أدنى من المستوى الأقصى . 3- خطر الاكتشاف : (2) " ويقصد بخطر الاكتشاف احتمال فشل المراجع في اكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية في القوائم المالية التي لم يتم منع حدوثها أو اكتشافها من خلال نظام الرقابة الداخلية المحاسبيـة . وتجدر الإشارة إلى أن خطر المراجعة يمثل احتمال مشترك لمكوناته الثلاثة ( الخطر الحتمي وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف ) ويعتبر خطر الاكتشاف العنصر الوحيد القابل للتحكم من قبل المراجع من خلال زيادة أو تخفيض حجم الاختبارات الأساسية . حيث يستطيع المراجع التحكم في خطر الاكتشاف في مرحلتي تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة عن طريق القيام بتحليل وتقييم الخطر الحتمي وكذلك فحص وتقدير خطر الرقابة . ويمكن للمراجع تقليل نسبة خطر الاكتشاف عن طريق القيام باختبار الالتزام بنظم الرقابة الداخلية ويقوم المراجع بهذا الاختبار عن طريق عمل زيارات متكررة لمواقع وفروع المنشأة محل المراجعة أسبوعيا أو شهريا وذلك لملاحظة تشغيل أنظمة الرقابة وتزداد أهمية القيام بهذا الاختبار كلما ازدادت نظم المعالجة الآلية تقدما وتعقيدا . ويرى الباحث : أن استخدام الحاسب يسمح للمراجع في جمع وتقييم أدلة الإثبات التي تدعم فعالية الاختبارات الأساسية وذلك عن طريق فحص كميات متزايدة من الأدلة التي تؤيد صحة وصدق القوائم المالية مما يجعل المراجع قادرا على التحكم في خطر الاكتشاف بدرجة أكثر فعالية . ثانيا : الأساليب الرقابية التي يمكن بها تأمين الأنظمة الالكترونية ضد المخاطر المختلفة : يمكن النظر إلى هذه الأساليب على أنها عبارة عن حلقات تتضمن مستويات مختلفة للرقابة حيث إذا ما أخفق أحد هذه المستويات في درء الخطر انتقلنا إلى مستوى أخر من الرقابة ويمكن تلخيص هذه المستويات على النحو التالي :(1) 1- مرحلة منع وقوع الخطر : في هذه المرحلة يكون الهدف الرئيسي للرقابة في تجنب حدوث الخطأ . 2- مرحلة اكتشاف الخطر : وتهدف إلى تصميم الطرق الخاصة بمراقبة المخاطر المختلقة المحتمل أن يتعرض لها النظام الالكتروني والتقرير عنها للمسؤولين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة . 3- مرحلة الحد من الآثار الناتجة عن الخطر : بصفة عامة إذا مخا تم وقوع الخطر فإنه يجب أن يكون هناك من الإجراءات والامكانات المتاحة التي تساعد على تخفيض الخسائر الناجمة عن الأخطار وعلى سبيل المثال إن الاحتفاظ بنسخة إضافية من الملفات الرئيسية سوف يساعد على حماية المعلومات في حالة تعرض الملفات الرئيسية الموجودة في مركز الكمبيوتر للمخاطر التي يمكن أن ينجم عنها فقد تلك الملفات كليا . 4- مرحلة التحري والتحقق : وذلك عن طريق القيام بإجراء تحريات دقيقة والتحقيق عن الظروف التي أدت إلى حدوث هذه المخاطر وبصفة عامة فإن المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال هذه التحريات يمكن استخدامها عند تخطيط سياسة الأمن المتعلقة بالأنظمة الالكترونية . ويرى الباحث : إن إتباع هذه المراحل سوف يساهم في سلامة وصحة النظام الالكتروني وبياناته وذلك من خلال تخفيض الآثار والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام الالكتروني إلى أقل حد ممكن .
- بواسطة الادمن
- January 11, 2026
مفهوم تقويم الاداء
يقصد بتقويم الاداء قياسة وتحديد مستواه – بناء على بيانات ومعلومات عن هذا الاداء – ومقارنتة بما كان مخطط ومستهدف ، ثم أتخاذ قرار بتصحيح وتوجية مسارات الاداء وفق الخطط والبرامج المستهدفة ، وبما يعمل على تحقيق الاهداف وترشيد التخطيط في المستقبل وتحقيق التطور والنمو المستمر . ويرى أحد الكتاب أن تقويم الاداء يقصد به التأكد من كفاية استخدام الموارد المتاحة افضل استحدام لتحقيقة الاهداف المخططة من خلال دراسة مدى جودة الاداء واتخاذ القرارات التصحيحية لاعادة توجية مسارات الانشطة في المنشاة بما يحقق الاهداف المرجوه منها . ومن التعريفين السابقين يمكن القوم ان تقويم الاداء يهدف بشكل اساسي إلى اتخاذ القرار الخاص بتنمية الاداء الحسن وتصحيح مسارات العمل ، سواء بتصحيح اسلوب العمل او بتصحيح خطط وبرامج وسياسات العمل ذاتها إذا ثبت قصورها ، وعدم مناسبتها لظروف العمل وبيئة العمل. أي ان عملية تقويم الاداء ليست غاية في حد ذاتها ، ولكنها وسيلة لتحسين الاداء وتطويرة .
- بواسطة مدير التحرير
- January 11, 2026
مفهوم القروض و انواعها
مفهوم القروض و انواعها اولا- مفهوم الائتمان المصرفي Bank Credit يعد الائتمان المصرفي اكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية , نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الاخرى , و من بعد فهو الاستثمار الاكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية ( Profitability ) . و قد وردت تعاريف كثيرة لمفهوم الائتمان ، منها انه قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع و الخدمات و الممتلكات أو الحقوق فيها مقابل دفع القيمة المساوية لها و المتفق عليها في المستقبل و يعرف كذلك بانه مقياس لقابلية الشخص المعنوي أو الاعتباري للحصول على القيم الحاضرة ( النقود أو البضائع أو الخدمات ) مقابل تأجيل الدفع ( النقدي عادة ) الى وقت معين في المستقبل. و عليه فان الائتمان المصرفي يتمثل بصفة اساسية في القروض ( Loans ) التي تمنحها المصارف لزبائنها من الافراد أو الهيئات أو المصارف التجارية الاخرى ، و يحمل هذا الاستثمار من جانب المصارف في طياته مخاطرة ( Risk ) عدم قيام هؤلاء المقترضين ( Borrowers ) (الزبائن) في سداد القرض و فوائده في الوقت المحدد للمقرض ( Lender ) و هو المصرف . و اذا كان مفهوم الائتمان ينصرف اساسا الى القروض كما تبين ، فهناك استثمارات غيرها تمثل انماط اخرى للائتمان المصرفي ، مثل اصدار بطاقات الائتمان المصرفية ( Bank Credit Cards ) ، فهذا النظام يسمح لحامل البطاقة بشراء ما يحتاجه من سلع أو خدمات من المؤسسات التجارية أو الخدمية التي تقبل التعامل بتلك البطاقات ( كالمؤسسات التجارية المختلفة و الفنادق و المستشفيات و المطاعم ) دون الحاجة لقيام الزبون بالسداد النقدي الفوري . كما يمكن اعتبار خصم الاوراق التجارية ( كالكمبيالات مثلا ) نوعا من انواع الائتمان المصرفي قصير الاجل ، و يقصد بخصم الكمبيالات ( Discounting ) قبول المصرف لشراء الكمبيالة من المستفيد قبل ميعاد استحقاقها في مقابل دفع ثمن يقل عن قيمتها و في هذه الحالة تصبح قيمة الكمبيالة ضمن اصول المصارف ويحق له توظيفها في مجالات استثماراته المختلفة . و يمكن للمصارف اعادة خصم تلك الكمبيالات لدى البنك المركزي أو اعادة بيعها مرة ثانية لمصارف تجارية اخرى ، و يطلق على عملية قيام المصرف بخصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي مصطلح شباك الخصم. ومن الضروري التفرقة هنا بين الائتمان المصرفي ، و هو ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل ، و بين الائتمان التجاري( Trade Credit ) ، فالائتمان الاخير يتمثل في الديون الناشئة من التعاملات التجارية الآجلة و المسجلة في اوراق تجارية ( كمبيالات ) تمثل للدائن ( البائع ) اوراق قبض ( Receivable ) و للمدين (المشتري بالاجل ) اوراق دفع(Payable) كما, ويعد الائتمان المصرفي اقل تكلفة من الائتمان التجاري و خاصة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي الممنوح للتاجر في حالة السداد قبل تاريخ الاستحقاق و لذلك فان كثيرا من التجار يلجأون الى الحصول على ائتمان مصرفي لفترة محددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنح لهم لفترة محددة . و يجب على من يستخدم أو يستعمل الائتمان التجاري ان يدرك عناصر التكلفة التي تختفي وراء الخصم النقدي ، فالكلفة ليست مقتصرة على نفقة استعمال الاموال بل تمتد لتشمل نفقة الديون المعدومة المتوقعة و النفقات الاضافية الناتجة عن منح الائتمان .
- بواسطة الادمن
- January 11, 2026
مفهوم التحليل المالي وأهميته:
مفهوم التحليل المالي وأهميته: 1- مفهوم التحليل المالي The Concept of Financial Analysis: التحليل المالي بصورة مبسطة هو مجموع الأساليب والطرق الرياضية والإحصائية والفنية التي يقوم بها المحلل المالي على البيانات والتقارير والكشوف المالية من اجل تقييم أداء المؤسسات والمنظمات في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل [1] . في حين يرى آخرون أن التحليل المالي [2] على انه (( مدخل أو نظام لتشغيل البيانات لاستخلاص معلومات تساعد متخذي القرارات التعرف على: الأداء الماضي للمنشاة وحقيقة الوضع المالي والاقتصادي للمنشاة في الوقت الحالي. التنبؤ بالأداء المالي للمنشاة في المستقبل. تقييم أداء الإدارة. )) إذا طبقا للتعريف أعلاه فان التحليل المالي هو عملية استخلاص المعلومات من البيانات المتوفرة من اجل التعرف على أداء المنشاة في الماضي والتنبؤ باداءها في المستقبل وتقييم أداءها الحالي وذلك من اجل مساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات. بعض المختصين يرى أن التحليل المالي [3] (( هو حساب النسب التحليلية من القوائم المالية وتفسير هذه النسب لمعرفة اتجاهاتها كأساس للقرارات الإدارية.)) هذا التعريف يشابه التعريف السابق في أن التحليل المالي هو لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات لكنه يعتبر التحليل المالي أو يختصره بالنسب المالية، في حين أن التحليل المالي لا يُختصر فقط بالنسب المالية بل هو أوسع من ذلك، كما سنرى خلال البحث. مختصون آخرون [4] يرون أن التحليل المالي بأنه (( عبارة عن عملية معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة عن مؤسسة ما للحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ قرارات وتقييم أداء المؤسسات التجارية والصناعية في الماضي والحاضر وكذلك في تشخيص أية مشكلة موجودة – مالية أو تشغيلية – وتوقع ما سيكون عليه الوضع في المستقبل)). هؤلاء المختصون يرون أن التحليل المالي هو عملية معالجة للبيانات وهو إقرار بان التحليل المالي هو في حقيقته نظام معلومات وان لم يصرَحوا عن ذلك، لكن المعنى المستفاد يفضي إلى ذلك. البعض الآخر من المختصين [5] يرون، على أن التحليل المالي عبارة عن نظام معلومات حيث أن مدخلات هذا النظام تتمثل بالمعلومات المحاسبية ( قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية وغيرها من القوائم) ومعلومات غير محاسبية كأسعار الأسهم وبعض البيانات الاقتصادية كالتضخم والنمو وغيرها، بينما عمليات هذا النظام تتمثل باستخدام أساليب التحليل المالي المختلفة، في حين أن مخرجات نظام التحليل المالي تتمثل بالمعلومات التي يقدمها التحليل المالي من نسب مالية أو مؤشرات أو أشكال بيانية. ويعتقد الباحث صحة هذا الرأي الذي يعتقد في أن التحليل المالي يعتبر نظاما للمعلومات لكن هؤلاء المختصين لم يبينوا التغذية العكسية لهذا النظام، فطبقا لنظرية النظم [6]، فان أي نظام يتمثل بوجود مدخلات وعمليات تُجرى على هذه المدخلات ومن ثم فان هناك مخرجات لهذا النظام ولكي تكتمل الدورة ومن اجل أن يتكامل النظام ينبغي أن توجد تغذية عكسية، وذلك من اجل أن يتطور النظام ومن اجل أن يواكب التغير الحاصل في البيئة. الباحث يرى أن التغذية العكسية لهذا النظام "نظام التحليل المالي" تتمثل بالتحقق من صحة هذه المخرجات التي قُدمت على شكل نسب أو طرق رياضية أو إحصائية ومدى مطابقتها للواقع – أي إجراء عملية مقارنة - سيما ما يخص التنبؤ بالمستقبل أو التنبؤ بالفشل المالي من اجل تصحيح وتطوير طرقه وأساليبه كي تتطابق مع الواقع أو تكون قريبة منه وهذا ما يفسر تطور التحليل المالي في الفترة الأخيرة . ومن المهم جدا التنويه إلى أن أي نظام يتكون من أنظمة فرعية [7] والتحليل المالي يتكون بدوره من أنظمة فرعية "كنظام التحليل المالي الفرعي لدراسة وتحليل المبيعات، نظام فرعي لدراسة قوى العمل، نظام فرعي لدراسة رأس المال والديون، ....الخ". إذا التحليل المالي عملية تقويمية ورقابية وهو كذلك نظاما للمعلومات حيث انه يستمد مدخلا ته من بيانات وأرقام وتقارير وكشوفات من المنشات المختلفة ومن البيئة الخارجية سواء كانت منها القطاع الذي تعمل فيه هذه المنشاة أو تلك أو البيئة الأكبر " المدينة، البلد، المحيط الإقليمي، الدولي" ومن ثم يقوم بإجراء العمليات على هذه البيانات والأرقام بطرق خاصة ومعروفة للمختصين ومن ثم فان مخرجات هذا النظام تتمثل بالتقارير والنسب والمخططات والمشورة التي يقدمها للمستويات الإدارية المختلفة سواء في المنشات والمنظمات أو على مستوى الاقتصاد الكلي، أما لتغذية العكسية لهذا النظام "نظام التحليل المالي" فانه يتمثل بالتحقق من صحة هذه المخرجات التي قدمت على شكل نسب أو طرق رياضية أو إحصائية ومدى مطابقتها للواقع. الباحث يقترح أن تكون هناك اختصاصات فرعية في مجال التحليل المالي كي تكون عملية تقويم أداء المنشات اكبر وأكثر شمولية بحيث تشمل جميع مفاصل هذه المنشات من اجل تطوير وتحسين أداء المنشات ومن ثم تطوير الاقتصاد بصورة عامة، حتى تكون عملية اتخاذ القرارات ووضع الخطط والعملية الإدارية بصورة عامة عملية علمية ودقيقة تنطلق من خلال دراسة واقعية تأخذ جميع هذه العوامل بنظر الاعتبار. 2- أهمية التحليل المالي: لاشك أن أهمية التحليل المالي تنبع من أهمية هذه الدراسات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية في السنوات الأخيرة، حيث أن توسع المنظمات وتباعد مراكز وفروع هذه المنشات الجغرافية بالإضافة إلى توسع وتعقد العمليات الاقتصادية في العالم، وظهور حيل وأدوات جديدة من الغش والخداع والاختلاس، أدى إلى ضرورة وجود أداة رقابية فعالة هي التحليل المالي، وبصورة عامة فان أهمية التحليل المالي تتمثل بالاتي[8] : التحليل المالي أداة من أدوات الرقابة الفعالة وهي أشبه بجهاز الإنذار المبكر والحارس الأمين للمنشاة سيما إذا استخدم بفعالية في المنشات. يمكن استخدام التحليل المالي في تقييم الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع وتقييم الأداء. التحليل المالي أداة من أدوات التخطيط حيث انه يساعد في توقع المستقبل للوحدات المستقبلية. التحليل المالي أداة من أدوات اتخاذ القرارات المصيرية سيما ما يخص قرارات الاندماج والتوسع والتحديث والتجديد. ثانيا: خطوات التحليل المالي، الجهات المستفيدة منه، مصادر معلومات التحليل، وأنواع التحليل المالي: خطوات التحليل المالي: هناك خطوات محددة يستخدمها المحلل المالي في عملية تحليله ولعل أهمها الآتي [9]: تحديد الغاية أو الهدف من التحليل وهذا يتعلق بقرار الإدارة حول ماهية العمل الذي تريده فهل تريد تقييم الأداء النهائي، أم تريد إجراء تحليل قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته الجارية كما يحدث غالبا في البنوك على سبيل المثال عندما تريد منح قرض لأحد المنشات، أم يراد إجراء تحليل لإنتاجية العمل، وغيرها من الأهداف. بعد ذلك يقوم المحلل بجمع المعلومات المطلوبة حسب نوع التحليل فان كان هدف التحليل تقييم الأداء النهائي فان المحلل يقوم بجمع بيانات عن المصروفات والإيرادات لفترة معينة وتحديد المؤشرات الرئيسية التي لها دور كبير في أداء المشروع مثل المبيعات أو الإنتاج. ثم ينتقل المحلل بعد ذلك إلى تحديد أدواته التي سوف يطبقها في عملية التحليل وهذا يتعلق طبعا بالمستوى العلمي والفني للمحلل ومدى تجربته في مجال التحليل. هنا يقوم المحلل باستخدام البيانات ذات العلاقة من اجل الوصول إلى مؤشرات معينة يستفيد منها في عملية التحليل. بعد الوصول إلى مؤشرات معينة يقوم بتحليل هذه المؤشرات من اجل معرفة اتجاه هذه المؤشرات في المستقبل. ينتهي المحلل بعد ذلك إلى كتابة استنتاجاته وتوصياته على شكل تقرير يقدم إلى الجهة التي طلبت التحليل. الجهات المستفيدة من التحليل المالي User of Financial Analysis: هناك جهات عديدة تستفيد من التحليل المالي فمنها ما هو داخلي يخص المنشاة نفسها ويتمثل بالمستويات الإدارية المختلفة وهناك جهات خارجية تستفيد من التحليل المالي تتمثل بجميع الأطراف خارج المنشاة سواء كانت لهم صلة بالمشروع أو لا وبصورة عامة فان الجهات التي تستفيد من التحليل المالي هي [10] :إدارة المنشاة ملاك المنشاة والمستثمرين الحاليين والمتوقعين في المستقبل دائنو المنشاة والبنوك الجهات الحكومية وأجهزة الرقابة والضريبة مراكز الدراسات والبحوث البورصات وأسواق المال الجامعات والمعاهد شركات التامين الصحف والجرائد والمجلات النقابات مصادر معلومات التحليل المالي : يمكن تقسيم مصادر بيانات التحليل المالي إلى مصدرين هما [11]: مصادر داخلية: وهي مصادر من داخل المنشاة والتي تتمثل بالمعلومات المحاسبية والإحصائية والإدارية والاقتصادية. مصادر خارجية: وتتمثل بجميع المصادر التي تكون خارج المنشاة ولعل أبرزها أسواق المال ومكاتب السماسرة وهيئات البورصة والصحف المتخصصة والمجلات ودوائر الدولة المختلفة التي لها علاقة كوزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وأجهزة الإحصاء. بالإضافة إلى ذلك ينبغي التعرف على مستويات الربحية والأداء في القطاعات المختلفة كذلك القطاع الذي تعمل فيه المنشاة المراد إجراء تحليل لها بالإضافة إلى بعض التشريعات التي تتعلق بالضرائب والرسوم الكمركية وسواها، كذلك ينبغي معرفة الظروف الاقتصادية من كساد وتضخم ورواج وغيرها. أنواع التحليل المالي: هناك أنواع عديدة من التحليل المالي ناتجة عن طريقة التبويب التي يستخدمها المحلل أو المختص والأسس التي يعتمدها في التحليل. بصورة عامة سنشير إلى بعض هذه الأنواع [12]: حسب الجهة القائمة بالتحليل [13]: تحليل داخلي وهو التحليل الذي تقوم به جهة داخلية أي من داخل المنشاة المراد إجراء تحليل لها. تحليل خارجي: هذا النوع من التحليل تقوم باجراءه جهات من خارج المنشاة كالبنوك والمصارف والغرف التجارية والصناعية وفي أيامنا هذه المكاتب المتخصصة في الحسابات والتدقيق. حسب الزمن: تحليل رأسي "ثابت أو ساكن" [14]: يتم في هذا النوع من التحليل نسبة بند من بنود احد القوائم المالية الواحدة إلى مجموعة اكبر فمثلا يتم نسبة المدينين إلى الموجودات المتداولة أو نسبة المكائن والآلات إلى الموجودات الثابتة أو إلى إجمالي الموجودات وهكذا بالنسبة للخصوم هذا فيما يخص قائمة المركز المالي على سبيل المثال، أما بالنسبة إلى قائمة الدخل فيتم نسبة احد البنود إلى المبيعات، طبعا مع ملاحظة أن هناك علاقة بين البند والمجموعة التي ينسب لها من اجل أن تكون ذات مدلول. ويتسم هذا التحليل بالسكون والثبات لأنه يدرس العلاقة بين بندين أو مجموعتين في فترة زمنية محددة. تحليل أفقي "المتغير" [15]: هذا النوع من التحليل يتم عن طريق احتساب اتجاه التغير في العناصر الرئيسية للقوائم المالية من سنة إلى أخرى على شكل نسب مئوية من اجل توضيح التغيرات الحاصلة حيث يتم احتساب نسب التغير كما يأتي: قيمة التغير في أي عنصر = قيمة العنصر في سنة المقارنة(مثلا سنة 2006) – قيمة نفس العنصر في سنة الأساس (مثلا سنة 2003). نسبة التغير = قيمة التغير في النقطة (أ) / مبلغ سنة الأساس (سنة 2003). يمكن استخراج نسبة التغير بخطوة واحدة كآلاتي: نسبة التغير = [{قيمة العنصر في سنة المقارنة(سنة 2006) – قيمة نفس العنصر في سنة الأساس (سنة 2003)}/قيمة العنصر في سنة الأساس] * 100 حسب الهدف من التحليل [16]: تحليل قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير. تحليل قدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل الطويل. التحليل المالي لتقويم ربحية المنشاة. التحليل المالي لتقويم الأداء. التحليل المالي لتقويم التناسق في الهيكل التمويلي العام للمشروع ومجالات استخدامات. ثالثا: استعمالات التحليل المالي: يمكن استعمال التحليل المالي لخدمة أغراض متعددة ومن أهمها الآتي [17]: التحليل الائتماني Credit Analysis [18]: هذا التحليل بصورة عامة يقومون به المقرضين من اجل معرفة الأخطار التي سيواجهونها إذا منحوا قرضا لأحد الأطراف، لذا يقومون بتحليل مديونية الطرف الذي ينوون منحه قرضا من اجل التحقق من أن هذا الطرف قادر على إعادة القرض عند استحقاقه. التحليل الاستثماري Investment Analysis [19]: هذا النوع يهتم بعملية تقييم الأسهم والسندات وتقييم المؤسسات بصورة عامة، وهذا النوع يعتبر من الأنواع المهمة باعتبار أن الاستثمار هو مدار اهتمام نسبة كبيرة من الإفراد والمؤسسات. تحليل الاندماج والشراء Merger & Acquisition Analysis [20]: كما هو معروف فان عملية شراء شركة أو في مجال عملية الاندماج بين الشركات نحتاج إلى القيام بعملية تحليل مالي للمنشاة المراد شراؤها مثلا، من اجل الوقوف على القيمة الحقيقة للمنشاة ومن اجل معرفة موقع المنشاة في السوق بالإضافة إلى أمور كثيرة كالتنبؤ بمستقبل أداء هذه المنشاة وغيرها من أمور. وكما نعرف فان عملية شراء المنشات أو عملية الاندماج من الأمور المهمة والتي تكون مكلفة سيما إذا لم تكن قائمة على دراسة وتحليل دقيق وبالتالي فان الأهمية تتأتى من هذا الجانب. تحليل تقييم الأداء Performance Analysis [21]: هذا النوع هو الآخر من الأنواع المهمة ولعل غالبية الأطراف ( الإدارة والمستثمرون والمقرضون وغيرهم) تقوم بهذا النوع من التحليل باعتبار انه يقوم بتقييم المؤسسات من جهات عديدة كتقييم الربحية وكفاءة المؤسسة في إدارة موجوداتها أو توازنها المالي أو ما يتعلق بالسيولة والنمو وما إلى ذلك من خدمات جليلة يقدمها هذا النوع من التحليل. التخطيط planning [22]: يعتبر التحليل المالي من الأدوات الفعالة في مجال التخطيط حيث يُستعان به في وضع تصور لأداء المنشاة المتوقع وذلك عن طريق الاسترشاد بالأداء السابق لنفس المنشاة. وفي هذا المجال نستطيع القول أن التحليل المالي يلعب دورا فريدا في مجال تقييم الأداء السابق أو الأداء المتوقع. رابعا: معايير التحليل المالي Standards of Financial Analysis: هناك مجموعة من المعايير التي يستخدمها المحلل للتعبير عن مستوى الأداء المالي ومن هذه المعايير الآتي [23]: المعايير التاريخية [24] Historical Standards: هذه المعايير تعتمد على مؤشرات مالية تاريخية أي لسنوات سابقة فمثلا يتم مقارنة نسبة السيولة للسنة الحالية مع نسبة السيولة لأعوام ماضية (لنفس المنشاة) ومن ثم ملاحظة التغيرات الحاصلة، هل التغيرات إلى الأفضل أو إلى الأسوأ وهكذا بالنسبة للنسب أو المعدلات الأخرى. المعايير المستهدفة [25] Targeted Standards: المعايير المستهدفة تعني المعايير التي تعتمد عادة على الخطط المستقبلية للمنشاة والتي تمثل الموازنات التخطيطية، وهذه المعايير يستفيد منها المحلل أو الإدارة للتحقق عن مدى تطبيق الخطط الموضوعة. فالمحلل المالي يقوم بمقارنة المعايير المستهدفة مع المتحقق وبالتالي يحدد فيما إذا كانت هناك انحرافات سواء ايجابية أو سلبية، وبالتالي فان المعايير المستهدفة من الأدوات الهامة في عملية التخطيط أو الرقابة. المعايير الصناعية [26] Industrial Standards: هو معيار يوضع ضمن صناعة معينة سواء ضمن صناعة واحدة محلية أو إقليمية أو دولية، ويحدد هذا المعيار طبقا لما هو متعارف عليه في السوق، طبعا هذه المعايير توضع من قبل مختصين سواء التجمعات المختصة في هذا المجال أو من قبل الاقتصاديين أو الإداريين أو المحللين الماليين أو الاستشاريين وغيرهم من ذوي الخبرة في هذا المجال، ويستفاد من هذه المعايير للمقارنة مع أداء المنشاة ومعرفة أداءها عن كثب. خامسا: الطرق والأساليب المستخدمة في التحليل المالي: للتحليل المالي طرق وأساليب فنية يستخدمها المحلل المالي من اجل الوصول إلى مؤشرات معينة أثناء القيام بعملية التحليل المالي وهذه الطرق منها ما هو تقليدي نشا مع بداية تشكل هذه المعرفة ولازال يشكل أهمية وفعالية في عملية التحليل المالي، كالنسب المالية، وهناك أساليب حديثة نشأت مع تطور العلوم الأخرى كالرياضيات والإحصاء وبحوث العمليات [27]. يتفق اغلب المختصين [28] على أن النسب المالية تنقسم إلى أربع مجموعات رئيسية وكل مجموعة تنقسم بدورها إلى مجموعة من النسب أو المعدلات المالية وهذه المجموعات الأربع هي الآتي: نسب السيولة. نسب الرفع المالي. نسب النشاط أو نسب الدوران. نسب الربحية. في حين أن بعض المختصين [29] يضيف مجموعة خامسة بالإضافة إلى المجموعات الأربع أعلاه، وهذه المجموعة هي، نسب السوق. ولكن نسب هذه المجاميع الخمسة لا تختلف بمجموعها عن المجاميع الأربعة لذا سيقتصر الباحث في استعراضه للنسب المالية على المجاميع الأربعة. قسم آخر من المختصين [30] يقسم النسب المالية حسب نوع القوائم المالية، فهو يقسم النسب كآلاتي: نسب قائمة المركز المالي. نسب قائمة الدخل. النسب المشتركة : أي المشتركة بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، أي أن النسبة المالية تتكون من عنصر ينتمي إلى احد القائمتين وعنصر آخر ينتمي إلى القائمة الأخرى وبالتالي فان النسبة تتكون من بسط ومقام ينتمي إلى القائمتين، ولكن ينبغي أن تكون هناك علاقة بين العنصرين اللذين أُخذت النسبة لهما وإلا سوف لن يكون هناك معنى للنسبة. النسب المالية المعيارية. بصورة عامة فان هذا التصنيف لا يختلف عن التصنيفات الأخرى من حيث طبيعة النسب المالية، لكن العملية تعتمد على الباحث أو المختص ووجهة نظره في كيفية عرض النسب ومدى بساطة ووضوح عملية التصنيف والعرض لهذه النسب. ولا تخلو هذه العملية من الايجابيات على كل حال بينما يذهب البعض الآخر من المختصين [31] إلى اعتبار أن كل النسب المالية (المجموعات الأربع أعلاه) هي من الأساليب التقليدية - لكنها على كل حال تبقى مهمة ولها اثر مهم في عملية التحليل المالي- وان هناك أساليب حديثة كالأساليب الرياضية والإحصائية وبحوث العمليات. سيتناول الباحث بالشرح المجموعات الرئيسية الأربع للنسب المالية ومن ثم سيسلط الضوء على الأساليب الحديثة. التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداءوالكشف عن الانحرافات إعداد علي خلف عبد الله إشراف