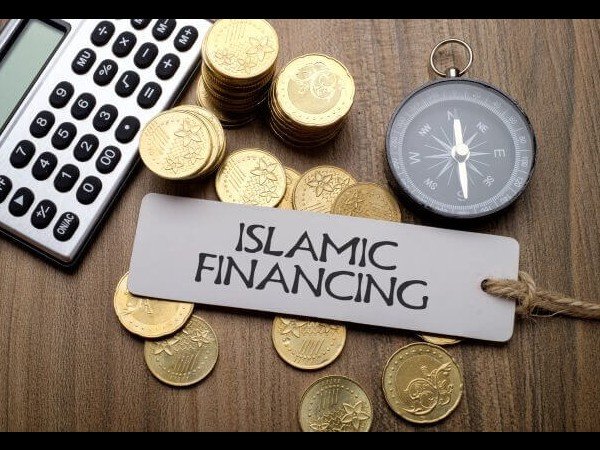المحاسبة المالية
- المحاسبة المالية -
- الرئيسية
- المحاسبة المالية
- المحاسبة الادارية
- محاسبة تكاليف
- التحليل المالي
- الاقتصاد
- بنوك
- محاسبة الضرائب و الزكاة
- المحاسبة الاسلامية
- تطوير المحاسبين
- التأمينات
- قسم تجارة الفوركس
- قسم البرامج المحاسبية
- موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
- المراجعة وتدقيق الحسابات
- القوائم المالية
- دراسات الجدوى
- المحاسبة باللغة الإنجليزية
- المحاسبة الحكومية
- محاسبة الشركات
- إدارة أعمال
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

سجل بياناتك الان
- بواسطة مدير التحرير
- February 26, 2026
أهداف البنوك الإسلامية
أهداف البنوك الإسلامية ظهرت البنوك الإسلامية بعد حركة الاستقلال من الاستعمار في الخمسينات الميلادية ،حيث بدأت متمثلة في بنوك الإدخار في مصر 1963م ثم أعقبتها محاولات أخرى في باكستان ثم بنك ناصر الاجتماعي عام 1971م ثم البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية عام 1974م ، وهكذا تتابع قيام البنوك الإسلامية الأخرى (1) . والبنك الإسلامي : هو مؤسسة مالية مصرفية تقوم على الوساطة المالية ولا تعمل بالفائدة (2) . وتسعى البنوك الإسلامية إلى تحقيق العديد من الأهداف سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعبدية وسوف نستعرض هذه الأهداف فيما يلي إجمالاً : 1- إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات الربوية لرفع الحرج عن المسلمين في إطار أحكام الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأكُلُواْ الرِّبَواْ أَضعافاً مُّضعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلّكُم تُفلِحُونَ [ (3) . 2- تنمية وتثبيت القيم العقدية والخلق والسلوك الحسن لدى العاملين والمتعاملين مع البنك الإسلامي . 3- تنمية الوعي الإدخاري والحث على عدم الإكتناز وتشجيع الاستثمار وذلك بتنمية الأوعية الإدخارية والاستثمارية المناسبة من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة وابتكار الصيغ الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . 4- تجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظيف بهدف تمويل المشروعات التجارية والصناعية ... إلخ مما يوفر الأموال لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية (1). 5- تحقيق التنسيق والتعاون والتكافل بين مختلف الوحدات الاقتصادية في المجتمع والتي تسير وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وخاصة البنوك الإسلامية . 6- تأكيد دور البنوك الإسلامية في السوق المصرفية القائمة وتحقيق الانتشار الجغرافي وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء والعمل على توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك الإسلامية (2) . 7- إن البنوك الإسلامية تسعى لأقصى ربح يسمح به الشرع من حيث معدل الربح ومصدره لكونها بنوكاً إسلامية ومؤسسات تجارية في آن واحد . 8- تحاول البنوك الإسلامية أن يشمل نشاطها كل القطاعات الإنتاجية وكل الفئات والمناطق مع إعطاء الأولوية للسلع الضرورية والخدمات الأساسية (3) . 9- القيام بالأعمال والخدمات المصرفية بمقتضى الشريعة الإسلامية خالية من الربا والاستغلال ، وهذا يعني أن البنك الإسلامي يجب أن يأخذ في اعتباره ما يلي : أ- توجيه الاستثمار وتركيزه على إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجات السوية للإنسان . ب- أن يقع المنتج سلعة كانت أو خدمة في دائرة الحلال . قال تعالى : ] قُل لاّ يَستَوِى الخَبِيثُ وَالطَّيِبُ وَلَو أَعجَبَكَ كَثرَةُ الخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللهَ يَأُوْليِ الأَلبَبِ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ [ (1) ج- تحرى أن تكون جميع مراحل العملية الإنتاجية ( التمويل – التصنيع – التوزيع – البيع – الشراء ) ضمن دائرة الحلال . د- أن تكون جميع أسباب الإنتاج ( أجور – نظام – عمل ) حلالاً (2) .
- بواسطة مدير التحرير
- February 26, 2026
البنوك الإسلامية والتقليدية
البنوك الإسلامية والتقليدية جاءت البنوك الإسلامية لخدمة الإسلام ورفع الحرج عن المسلمين وبيان أوجه الاستخدامات المختلفة للأموال في الاقتصاد الإسلامي والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية . ومرت البنوك الإسلامية بتطورات كبيرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من جميع المجالات سواء الخدمات المصرفية أو طرق الاستثمار والتمويل . وتتنافس البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في جذب أموال المودعين واستثمارها ولا شك أن البنوك التقليدية شعرت بهذه المنافسة ففكرت في إيجاد صيغ استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية . وسوف نبحث في هذا الفصل كيفية الحصول على الأموال في البنوك التقليدية واستخداماتها مع مقارنتها بتلك الموجودة في البنوك الإسلامية وسوف نبين أوجه العلاقة والتشابه والإختلاف بين البنك التقليدي والبنك الإسلامي . وقبل كل ذلك سوف نتعرف على أهداف البنوك الإسلامية من خلال المباحث التالية :
- بواسطة مدير التحرير
- February 26, 2026
علاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية
علاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية أولاً : أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك التقليدية والإسلامية : 1- تركيز البنوك التقليدية على الإقراض بفائدة والإسلامية على الاستثمار بالطرق الشرعية : إن أحد أوجه الاختلاف الجوهرية بين البنوك الإسلامية والتقليدية هو أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً وأساس ذلك تحريم الربا في الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] وَأَحَلَّ اَلَّلهُ اَلبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوَا [ (1) . ونتيجة لذلك فإن البنوك الإسلامية تتخذ أشكالاً مختلفة عن تلك المستخدمة في البنوك التقليدية بحيث لا تتعامل بالربا المحرم (2) . وقد أمر الله تعالى بترك الربا وعدم التعامل به قال تعالى : ] يَأيُّهَا الّذّينَ آَمَنُوا أتَّقُوا الله وذَروُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبواْ إِن كُنتُم مُّوْمِنينِ [ (3) . ومما يفهم من هذه الآية أن من مقتضيات الإيمان ترك الربا ، فبين الله تعالى أن الربا والإيمان لا يجتمعان ] إِن كُنتُم مُّؤمِنيِنَ (4) . وتعتمد البنوك التقليدية في توظيف الأموال على الإقراض بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الذي تقترض به والفرق بين الفائدتين هي الأرباح التي تحققها من عملية الإقراض بفائدة . أما البنوك الإسلامية فإن الاستثمار بصوره المختلفة المقبولة شرعاً هو الوسيلة المتاحة أمامها لتحقيق الأرباح . ويشمل كذلك الصيغ الأخرى المقبولة شرعاً والتي تحقق العائد المجزي من خلال المرابحة والمضاربة والمشاركة والتأجير والسلم وغيرها من الصيغ الشرعية . 2- مقارنة أهداف البنوك التقليدية والإسلامية : وضع الإسلام شروطاً خاصة لاستخدام المال والتصرف فيه وطرق كسبه ووسائل صرفه مثل وجوب إتباع أفضل السبل في استثمار المال ، وأداء الزكاة ، ومنع التصرف بالمال مما يلحق الضرر به أو بغيره أو بالمجتمع ، ومنع تنمية المال بغير الوسائل التي أجازها الشارع مما أدى إلى أن يكون للبنوك الإسلامية أهدافاً تختلف عن أهداف البنوك التقليدية . فالبنوك التقليدية تستهدف فقط تحقيق أقصى معدّل من الربح وهي بذلك تهتم بالأغنياء وتركز على المشروعات الكبيرة والقروض بغض النظر عن نوعية المشروع ولا تهتم كثيراً بالنواحي الاجتماعية . أما البنوك الإسلامية فإن الإسلام وضع القيود على استثمار المال لتحقيق الربح الحلال كما أن لها أهداف أخرى اجتماعية وإنسانية . 3- الاختلاف في أسس التمويل المصرفي : تعتمد البنوك التقليدية على أسس مختلفة في التمويل المصرفي عن تلك الموجودة بالبنوك الإسلامية . فالبنوك التقليدية تشترك في معرفة الغرض من التمويل وفترته والمخاطر المتوقعة والضمانات الكافية واللازمة لرد المبلغ المقترض وتحديد سعر الفائدة مسبقاً ، ويقتصر التمويل في الغالب على المشروعات والمنظمات الكبيرة . أما البنوك الإسلامية فإن لها أسساً مختلفة في عملية التمويل منها : أ- توافر الشرعية في المشروعات الاستثمارية موضع التمويل . ب- تطبيق الصيغ الإسلامية في عملية الاستثمار . ج- تمويل مختلف المشروعات الاستثمارية النافعة للمجتمع. د - تحريم التعامل بالفائدة (1) . 4- الإختلاف في الودائع : تعتمد البنوك التقليدية والإسلامية على الودائع الجارية الدائنة لديها كأحد المصادر الخارجية المهمة في الحصول على الأموال (2) . وهذه الودائع في النظام الربوي إما أن تكون طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو لفترات قصيرة تقل عن السنة أو تودع في شكل حسابات جارية لا تحصل في الغالب على فائدة ربوية . أما النظام المصرفي الإسلامي فإن هذه الودائع تتخذ أشكالاً متعددة أما أن تكون وديعة بدون فائدة ( الحسابات الجارية ) أو وديعة استثمار . ويتركز الاختلاف أساساً في أن ودائع العملاء في النظام الربوي يتحدد لها فائدة ثابتة ترتبط بالزمن مقدماً . أو تكون مغيرة حسب أسعار الفائدة في السوق وليس على أساس نتائج الأعمال وهو ما لا تقره الشريعة الإسلامية(3). 5- الاختلاف في الآلية : تختلف بعض الإدارات والأقسام داخل البنوك التقليدية عن تلك الموجودة بالبنوك الإسلامية . فالبنوك الإسلامية تحتوي على إدارة أو هيئة للرقابة الشرعية للبحث في صور استثمارات البنك بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية ، ويوجد بها أيضاً إدارة أو قسم لحساب الزكاة على الأموال ، بينما نجد اختلاف في بعض الإدارات من حيث الحجم وثقلها النسبي في البنوك التقليدية والإسلامية مثل إدارة الإقراض والاستثمار وأقسام المتابعة والتنفيذ (1) . ثانياً : علاقة البنك الإسلامي بالبنوك التقليدية : كان من الطبيعي أن تنشأ علاقات تعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية القائمة ، فالبنك الإسلامي يتلقى الشيكات والأوراق التجارية ويقوم بالتحويلات لمصلحة عملائه وغير ذلك من العمليات المصرفية اليومية مما يتطلب معه قيام البنك الإسلامي بالتعاون مع البنوك التقليدية . وهذه المعاملات أو الخدمات التي يقوم بها البنك الإسلامي لا مانع منها شريطة أن يكون تعامل البنك الإسلامي مع غيره من البنوك التقليدية خالياً مما حرمه الله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود على الرغم من أن أكثر أموالهم ربوية وقد قرر الفقهاء جواز التعامل مع من ماله خليط من الربا وغيره ، وهذا لا يمنع أيضاً من دخول البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في تمويل مشروعات مختلفة شريطة أن يكون التمويل على أساس المشاركة في رأس المال وفي الربح الناتج وهنا يكون كل من البنك الإسلامي والتقليدي شريكين في الغرم والغنم على حسب ما يتفقان عليه (2) أو بأي صيغة استثمارية أخرى كالمرابحة أو المضاربة أو أي صيغة أخرى طالما التزمت بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في عملية الاستثمار والتمويل. وعلى الرغم من اختلاف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من حيث الأهداف والأنشطة والعمليات التي تزاولها إلا أنها تقوم بتقديم بعض الخدمات المصرفية المعتادة مما يفسح المجال للتعامل مع غيرها من البنوك التقليدية القائمة ، وقد حددت البنوك الإسلامية أسلوب هذا التعامل بحيث يكون بعيداً عن أي شبهة ربوية . (1) سورة البقرة ، آية 275 . (2) نصر الدين فضل المولى – المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 19 . (3) سورة البقرة ، آية 278 . (4) فضل الهي – التدابير الواقية من الربا في الإسلام ، إدارة ترجمان الإسلام ، باكستان ط1 ، 1406هـ ص 48 (1) نصر الدين فضل المولى – المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 22-23 . (2) شوقي إسماعيل شحاته – البنوك الإسلامية ، دار الشروق ، جدة ، ط1 ، 1977م ، ص 68 . (3) عبد العزيز حجازي ، آفاق التعاون بين المصارف الإسلامية والربوية (المصارف الإسلامية) اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، 1989م ، ص 64-65 . (1) نصر الدين فضل المولى – المصارف الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 24 . (2) عبد الله الطيار – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 317 .
- بواسطة مدير التحرير
- February 26, 2026
شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية
شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلامية أولا : المعرفة التامة : يستفاد من عرض معالم السوق الإسلامية في اشتراط التعريف والتوصيف التام والدقيق للمبيع ، وللسعر ، ولظروف السوق ، والمتعاملين فيها تحصيل المعرفة التامة للمتعاقدين كصفة جوهرية نصت عليها الآثار الكريمة ، وقد منعت الأحكام كل ناقض لهذا الشرط ، فلا غرر ، ولا تغرير ، ولا تدليس بما يسوغ القول وبلا تحفظ عن معرفة تامة مؤمنة واختيار واع لكلا المتعاملين ، من خلال استقراء الأحكام المتعلقة بذلك ، ومنها الرضا الذي هو ركن التبادل يستلزم العلم على نحو مؤكد . واستكمالا للمبدأ الأساسي ، وتحوطا له واحتواء لأي خرق فيه ، تكفل الأحكام خطا دفاعيا آخر هو مبدأ الخيار للمتعاقدين ، والفقه الإسلامي يعرفنا بأشكال مختلفة منه وحسب مقتضياتها وهذه الخيارات هي : 1 – خيار المجلس : للحديث : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ، وكالما لم ينفض مجلسهما فهما بالخيار بين إنفاذ ما عقداه أو فسخه ، لا خلاف في ذلك . 2 – خيار العيب : ويكون للعاقد الذي لم يطلع على عيب لم يكن على علم به عند العقد . 3 – خيار الرؤية : بأن يكون للعاقد الذي عقد على شيء معين لم يره حق الفسخ إذا رآه ، وهو مجل خلاف بين الفقهاء ، سببه الخلاف في صحة العقد على الغائب ، فمن أثبت صحة العقد على الشيء المغيب ، الذي لم تسبق رؤيته اثبت خيار الرؤية . 4 – خيار الخلابة : والخلابة في العقد هي أن تخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهمة قولية أو فعلية ، تحمله على الرضا في العقد بما لم يكن ليرضى به لولاها ، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك بقوله : " إذا بيعت فقل : لا خلابة ، ولي الخيار ثلاثة أيام " ، وهذا الحديث منع ثابت في الشرع ، وإن لم يشترطه المتعاقد ،ومقتضاه ثبوت الخيار للمخدوع ، وقد ألحق بعض أهل العلم الغبن الفاحش بالخلابة للحديث: " غبن المسترسل حرام " . 5 – خيار الشرط أو التروي : " ولي الخيار ثلاثة أيام " ، فهذا الحديث صريح في إجازة الشرط ، والنص في الشريعة حاكم على العقود ، لا خاضع لأقيستها ، وقد اعترض ابن حزم على خيار الشرط سيما على مدته وقال عنها : إنها أحكام لا يعرف لها أصل . 6 – خيار الغبن : ويثبت للمتعاقد الذي يغبن في السعر ، كما هو الحال في تلقي السلع ، فقد جعل لهم النبي – صلى اله عليه وسلم – الخيار إذا هبطوا بها إلى الأسواق ، وعند ابن حزم توكيد بالغ في أن رد البيع من عيب ليس أولى من رده من غبن في السعر ، ونقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا رجوع للبائع والمشتري بالغبن قل أو كثر ، ورواية ابن القصار عن مالك : أن الغبن إذا بلغ الثلث فإنه يرد . ويقسم الغبن عند الفقهاء إلى قسمين : يسير : ما وقع ضمن تقدير المقومين ، وفاحش : ما تجاوز تقديرات المقومين جميعا ، وجعل متأخرو الحنفية الغبن الفاحش نصف عشر القيمة في العروض المنقولة ، وعشرها في الحيوان ، وخمسها في العقار . ثانيا : تجانس المعروض : إن تجانس السلع موضوع التبادل مردها إلى ذوق المستهلك وتقديره بصدد المنتجات المعروضة في السوق ، والتي تؤدي نفس الغرض ، وفي السوق الإسلامية لا يوجد ضابط ملزم للمنتجين بتنميط منتجاتهم ، والمستهلكين بتنميط أذواقهم أيضا . ثالثا : كبر عدد المشاركين في السوق وضآلة تأثير كل منهم : إن من شروط المنافسة التامة هو كبر عدد المشاركين في أسواق السلع والموارد ، وضآلة إسهام كل منهم في التعامل ، بحيث لا يكون له أثر معتبر في السوق ، إن هذا الشرط النظري ذرية المنافسة التامة لا يعكس موقفا مذهبيا معينا ،إنما حصيلة لظروف تتعلق بالعرض والطلب تجعل المتعامل آخذا للسعر لا محددا له ، ولا يشترط هذا في السوق الإسلامية ، بل حصن السوق من الميول التي تحاول الاستفادة من التركيز لأغراض خاصة ، دون أن يكون للتركيز ذاته وظيفة اقتصادية مبررة ، ومما يمثل لذلك النهي عن الحاضر للباد ، وأن يكون له سمسارا ، حيث بدت العلة مركزة التصريف دون مسوغ اقتصادي معتبر ، والنهي عن تلقي السلع ، الذي يوفر فرصة أكبر للقاء أكبر عدد من المشاركين في سوق معلومة الموضع ، والنص صراحة على بلعن المحتكر " المحتكر ملعون ، والجالب مرزوق " ، ووردت الأحكام التي تحصن السوق الإسلامية من محتكري البيع ، ومحتكري الشراء ، الذين يستغلون نفوذهم ، وتمركزهم لابتزاز الناس ، وورد النهي جملة عن بيع المكره ،وبيع المضطر ، وعن سوم الرجل عل سوم أخيه ، وعن بيع الرجل عل بيع أخيه . رابعا : حرية الحركة من وإلى السوق : لا يوجد في البناء الحكمي المنظم للسوق الإسلامية ما يحجر على أي من المشاركين حركته في دخول السوق أو الخروج منها ، بل إن تلك الحرية مكفولة ومدعومة أيضا بتأمين المعرفة التامة ، فلا جهل ولا إكراه ، ولا تواطؤ ولا احتكار شراء ، ولا احتكار بيع ، إلا ما كان مبرر ، ولا تسعير إلا ما دعت إليه الضرورة .وقد ختم المصنف قوله : لأنه في الوقت الذي تشترط فيه المعرفة التامة ، والتصرف المختار ، ووسائلها في السوق الإسلامية ،وفي الوقت الذي تتيح فيه الضوابط الإسلامية قدرا من حرية الحركة ، لا يقيده إلا الشرط الفني ، واعتبار المصلحة العامة ، ومن ثم الرفاهية الاجتماعية ، فإنه ليس هناك ما ينص على تجانس السلع ، أو كبر عدد المشاركين ، وإن كانت هناك ضوابط تحصن من الميول الاحتكارية غير المبررة ، فالأصل في الاقتصاد الإسلامي هو التخصيص الكفء والرفاهية الاجتماعية ،والبنية التي تكفلهما ، في حين كان الأصل في نظام السوق هو المصلحة الخاصة للمشروع الخاص ، وكانت الضوابط الملزمة بكفاءة التخصيص أو الرفاهية استثناء غالبا مما تعارض مع فلسفة المشروع الخاص ومنظومته القيمية .
- بواسطة مدير التحرير
- February 25, 2026
خصائص المصارف الإسلامية
خصائص المصارف الإسلامية إعداد: الدكتور هايل طشطوش تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي تمتاز المصارف الإسلامية بميزات فريدة عن غيرها من البنوك ومؤسسات التمويل، ولعلها في ذلك تنطلق من قواعد ومبادئ الشرع الحنيف ، فالتعامل المالي والمادي في الإسلام له أصولة وقواعده وليس تابعا لهوى الأفراد وميولهم، وذلك حفاظا عليهم وعلى حقوقهم من الهضم والضياع، ففي قوى المال الكبير يأكل الصغير والقوي يطغى على الضعيف وهذا من هوى النفوس وطباعا. لذا فقد جاءت المصارف الإسلامي بخصائصها لتقوم على هدى النصوص الكريمة وتسير وفقها ، ولعل من ابرز هذه الميزات والخصائص هو : حرمة التعامل بالفائدة (التعامل الربوي) . فالمصرف الإسلامي لا يقر التعامل بالفائدة، ولكن في ذات الوقت يحتاج إلى استرداد كل نفقاته وكذلك تحقيق بعض الربح، ولذا فقد يعمل على تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار المباشر لذا فان المصرف الإسلامي يسعى نحو التنمية عن طرق التوجه نحو الاستثمار، حيث يقوم المصرف نفسه بعبء توظيف الأموال في مشروعات تجارية وزراعية أو صناعية تدر علية عائداً. ومن ابرز أساليب تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية هو توظيف الأموال عن طريق الاستثمار بالمشاركة بمعنى مساهمة المصرف الإسلامي في رأس المال للمشروع الإنتاجي ويصبح البنك شريكا في ملكية المشروع وفي إدارته والإشراف عليه، وبالتالي يكون شريكا في الربح والخسارة ويتم ذلك بالنسبة التي يتفق عليها الشركاء. رأس المال المدفوع في المصرف الإسلامي يجب أن يسلم بكامله للبنك ولا يجوز أن ينقص منه شيئا كدين لدى أصحاب رأس المال بعكس الحال في البنوك التجارية. وهذا من الفروق الجوهرية التي تختلف بها المصارف الإسلامية عن البنوك التجارية الربوية. المصرف الإسلامي يعطي أهمية أكبر للودائع الآجلة بالنسبة لهيكل الودائع الكلي على عكس البنوك التجارية التي تعطي الأهمية الأكبر للودائع تحت الطلب الأمر الذي يمكن من توظيف أكبر قدر من الموارد المتاحة لدية في النشاط الاقتصادي. تمارس المصارف الإسلامية أنشطة متعددة تجمع بين أنشطة البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال وشركات التجارة الداخلية والتصدير والاستيراد وشركات الاستثمار المباشر وتوظيف الأموال. المصارف الإسلامية تقوم بواجبات المسؤولية الاجتماعية وذلك لأنها بنوك اجتماعية في المقام الأول حيث تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ليس فقط من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ولكن في كيفية توزيع عائد الأموال المستثمرة بعدالة، وغالبا ما تتم ممارسة المسئولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية من خلال إستراتيجية البنك وسياساته، حيث ان من ابرز مبادئ المصارف الإسلامية هو عدم الفصل بين التنمية الاقتصادية والتنمية النفسية والاجتماعية لأن هدفها هو تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار أو تعظيم العائد الإسلامي للاستثمار وليس العائد المباشر للاستثمار. المصارف الإسلامية ليست مجرد مؤسسات مالية وسيطة, ولكنها أكبر من ذلك فهي مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وتجارية وخدمية تتميز بالجدوى والكفاءة. وهي تجسيد للنظام الاقتصادي الإسلامي. تستخدم المصارف الإسلامية مواردها المتمثلة في الاستثمار المباشر والاستثمار بالمشاركة في رأس مال المشروعات على أساس صفقة معينة أو مشاركة متناقصة أو من خلال صيغ المرابحة. للمصارف الاسلامية مصادر تمويل مختلفة عن البنوك الربوية حيث تتكون مصادر التمويل في المصارف الإسلامية من مصادر داخلية وخارجية، حيث تتمثل مصادر التمويل الداخلية في رأس المال المدفوع والاحتياطات المختلفة، أما المصادر الخارجية فتتكون من الودائع بأنواعها المختلفة سواء كانت ودائع جارية أو ودائع لأجل. تمارس المصارف الإسلامية عمليات استثمار الأموال بنفسها ولا تدع العميل فريسة للسوق حيث إنها تتجه صوب الاستثمار المباشر أو بالمشاركة مع الغير، وهذا يظهر الفرق الكبير بين القرض والاستثمار ، حيث أن طبيعة البنوك الإسلامية هي طبيعة استثمارية وليست اقراضية فالقرض يكون محكوما عند منحه بضمانات عينية كافية يقوم بفرضها البنك على العميل لضمان استرداد أمواله، أما في الاستثمارات فإن البنك هو الذي يتولى مهمة البحث عن الاستثمارات وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة، وقد يقوم بعملية الاستثمار بمفرده أو بالمشاركة ويتحمل نتيجة الاستثمار إن كانت ربحا أو خسارة. ومن الميزات الجوهرية للمصارف الإسلامية هو مصدر تحقيق الربح حيث أن الاختلاف الأساسي بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية يدور حول سعر الفائدتين الدائنة والمدينة كمصدر مهم من مصادر تحقيق الأرباح بالإضافة إلى استثمارات المحفظة. المصارف الإسلامية لا تمارس عملية توليد النقود(الودائع) او ما يسمى بخلق الائتمان لانه لا يتعامل بالفائدة لذا نجد أن عملية خلقه للائتمان تكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي فبحكم مشاركة البنوك الإسلامية الفعلية في الإنتاج فإن النقود تتداول بين المصرف وعملائه في وقت ظهور الإنتاج وتختفي مع استهلاك ذلك الإنتاج لتعود مرة أخرى للمصرف، ومن هنا فإن حجم الإنتاج الحقيقي يظل معادلاً تماماً لحجم الائتمان حيث لا تتأثر مستويات الأسعار، ولا يحدث تضخم بسبب الزيادة في الكتلة النقدية يضاف إلى ذلك أن نظام المشاركة يربط المصارف الإسلامية بمشروعات انتاجية حقيقة وليست وهمية او افتراضية.