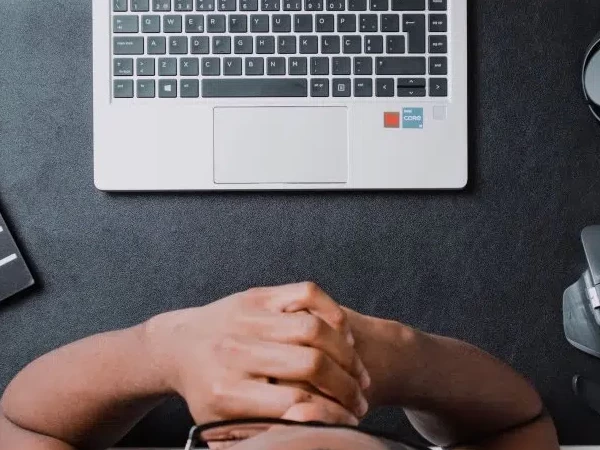المحاسبة المالية
- المحاسبة المالية -
- الرئيسية
- المحاسبة المالية
- المحاسبة الادارية
- محاسبة تكاليف
- التحليل المالي
- الاقتصاد
- بنوك
- محاسبة الضرائب و الزكاة
- المحاسبة الاسلامية
- تطوير المحاسبين
- التأمينات
- قسم تجارة الفوركس
- قسم البرامج المحاسبية
- موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
- المراجعة وتدقيق الحسابات
- القوائم المالية
- دراسات الجدوى
- المحاسبة باللغة الإنجليزية
- المحاسبة الحكومية
- محاسبة الشركات
- إدارة أعمال
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

سجل بياناتك الان
- بواسطة مدير التحرير
- January 12, 2026
بحث - تقييم دور بنك ناصر الاجتماعى فى علاج مشكلة الفقر
تحية إجلال للاخ تامر حلمي السيد سالم أبو آمنه وشكر خاص على ثقته في مجلة المحاسب العربي وأنه لشرف لنا جميعا أن نقوم بنشر هذا البحث على منصة مجلة المحاسب العربي راجين من الله لنا وله التوفيق وعضو خدمة أسأل المقدمة من مجلة المحاسب العربي
- بواسطة مدير التحرير
- January 12, 2026
نظام التقييم المصرفي CAMELS
نظام التقييم المصرفي CAMELS تم نشر المقال في العدد الحادي عشر لمجلة المحاسب العربي إن تطور العمل المصرفي وتعقيداته وتوسع وتنوع عملياته أوجد الحاجة إلى توفير نظم رقابية متطورة تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية للمصارف , وبيان وتوصيف المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي والإفصاح عنها بالشكل الذي يساعد مستخدمي القوائم المالية على الحكم على مدى قدرة المصرف على إدارة المخاطر والسيطرة عليها . ولهذه الغاية بدأ استخدام طريقة CAMELS في بداية عام 1980 من طرف المصرف الفيدرالي الأمريكي حيث تتمثل هذه الطريقة في مجموعة من المؤشرات التي من خلالها يتم تحليل الوظيفة المالية لأي مصرف , ومعرفة درجة تصنيفه وتعتبر هذه الطريقة من الوسائل الرقابية المباشرة التي تمارسها الجهات الرقابية على المصارف , ويتكون نظام التقييم المصرفي CAMELS من ستة مقومات هي[1] : · كفاية رأس المال Capital Adequacy · جودة الأصول Asset Quality · جودة الإدارة Management Quality · إدارة الربحية Earning Management · درجة السيولة Liquidity Position · الحساسية تجاه مخاطر السوق Sensitivity to Market Risk إن الغرض من استخدام نظام التقييم CAMELS، هو تحديد المخاطر المصرفية التي تشكل نقاط ضعف في العمليات المالية والتشغيلية والإدارية للمصرف والتي تتطلب بـذل عناية رقابية خاصة وتحديد أولويات الرقابة اللازمة، أو تدخل السلطة النقدية لمعالجة الأمر . وقد أثبت نظام CAMELSبأنه أداة رقابية فعالة لتقييم قوة المؤسسات المالية وبشكل موحد , كما أنه أثبت فعاليته في تحديد المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام خاص . مميزات معيار CAMELS : يمكن تلخيص أهم مميزات معيار CAMELS في النقاط التالية : - تصنيف البنوك وفق معيار موحد . - توحيد أسلوب كتابة التقارير . - اختصار زمن التقييم بالتركيز على ستة بنود رئيسية وعدم تشتيت الجهود في تقييم بنود غير ضرورية . - الاعتماد على التقييم الرقمي أكثر من الأسلوب الإنشائي في كتابة التقارير مما يقلل من حجم التقارير ويزيد في مصداقيتها . - عمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج موحد وتحليل النتائج أفقياً لكل مصرف على حدة ولكل مجموعة متشابهة من المصارف ورأسياً لكل عنصر من عناصر الأداء المصرفي الستة المشار إليها للجهاز المصرفي ككل . وبغية الوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة للتحليل الذي نقوم به , يتطلب نظام التقييم الموحد إجراء تصنيف رقمي لكل مصرف بالاستناد إلى العناصر الست الأساسية، ويحدد لكل عنصر تصنيف رقمي من (1إلى 5) حيث يكون التصنيف (1) الأفضل، والتصنيف (5) الأدنى، ويتم تحديد التصنيف النهائي للمصرف استناداً إلى تقييمات كل عنصر رئيسي من العناصر المذكورة والتي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في تقييمات العناصر المكونة لها، وبالتالي فإن المصارف التي يكون تصنيفها (4) أو (5) تشير إلى وجود مشاكل جدية وهامة فيها مما تتطلب رقابة جادة وإجراء علاجي خاص بها، فإذا ما تعرض المصرف إلى تهديد في ملاءته فإنه يصبح من الضروري توجيه الاهتمام الإداري والرقابي مع إيلاء الاعتبار إلى التصفية الإجبارية أو إعادة تنظيم المصرف. أما المصارف التي يكون تصنيفها (3) فهي بشكل عام تواجه بعض نقاط الضعف، وتستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها في إطار زمني معقول، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مشاكل بارزة في الملاءة والسيولة، مما يتطلب من المصرف المركزي اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة وتقديم إرشادات واضحة للإدارة لتحديد وتلافي نقاط الضعف المذكورة. أما المصارف التي يكون تصنيفها المركب (1 و2) فهي سليمة بصورة أساسية في معظم النواحي، وتعتبر ذات إدارة راسخة، وأن قدرتها على الصمود أمام التحديات جيدة باستثناء التقلبات الاقتصادية الحادة. إلا أن ذلك يتطلب وجود إشراف رقابي كحد أدنى لضمان استمرارية وصلاحية السلامة المصرفية الأساسية. أولاً – كفاية رأس المال Capital Adequacy : برز استخدام كفاية رأس المال في منصف القرن الماضي بمعادلة بسيطة تعبر عن العلاقة بين رأس المال والودائع ثم تطور لاحقاً بقيام لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية بإعداد بازل (1) والذي اشتمل على وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لقياس كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبة كفاية رأس المال (بازل 1 ) بنسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة المرجحة , حيث حددت نسبته بـ ( 8% ) وتم تطبيقه من قبل المصارف العاملة في اغلب دول العالم . ولكن بعد التطبيق لمعيار بازل1 ظهرت فيه بعض نقاط الضعف وبناء عليه فإن لجنة بازل قامت في عام 1999 بتقديم معيار جديد لكفاية رأس المال بهدف تعزيز سلامة ومتانة النظام المالي المصرفي وتغطية أشمل للمخاطر التي تواجه المصارف , حيث سمي هذا المعيار بمعيار بازل 2 ويمكن تصنيف رأس مال المصارف ضمن المجالات التالية : 1- المصرف الذي يصنف رأسماله (1) يتصف بالمؤشرات التالية: - أداء قوي للأرباح. - النمو الجيد للأصول. - خبرة الإدارة جيدة في متابعة مسارات الأعمال المصرفية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها وتحديد المستويات المناسبة لرأس المال اللازم لها. - معقولية توزيعات الأرباح على المساهمين، مع المحافظة على قدرة المساهمين والشركات القابضة على زيادة رأس المال بصورة مقبولة، (معقولية توزيع الأرباح: تعطي عائد للمساهمين دون إعاقة نمو رأس المال المطلوب). - الحجم المنخفض للأصول المتعثرة، وكفاية المخصصات المكونة لمقابلتها. 2- المصرف الذي يصنف رأسماله (2) لديه نفس خصائص المصرف الذي يصنف رأسماله (1) حيث تتجاوز نسب كفاية رأس المال المتطلبات القانونية، ولكن المصرف يمر بنقاط ضعف في عامل أو أكثر من العوامل المذكورة. فعلى سبيل المثال قد تكون ربحية المصرف قوية ويدير نموه بصورة جيدة ولكن أصوله تواجه مشاكل مرتفعة نسبياً، فضلاً عن إخفاق الإدارة في الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتدعيم المخاطر الملازمة لمسارات الأعمال. ورغم ذلك يمكن تصحيح نقاط الضعف المذكورة من خلال برامج زمنية معقولة بدون إشراف تنظيمي عن كثب. 3- المصرف الذي يصنف رأسماله (3) يتوافق مع كفاية رأس المال والمتطلبات التنظيمية للملاءة المصرفية ولكن هناك نقاط ضعف رئيسية في عامل أو أكثر من العوامل المذكورة. مما يتطلب قيام الإدارة والمساهمين بمناقشة سليمة للقضايا ذات الشأن، واتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين كفاية رأس المال. ومن أسباب التصنيف أيضاً وجود مستوى مرتفع للأصول التي تواجه مشاكل مقارنة برأس المال، فضلاً عن ضعف ربحية المصرف وضعف نمو أصوله. وهي في حد ذاتها عوامل مؤثرة بدرجة كبيرة على رأس المال مما ينعكس سلباً على قدرة المصرف والمساهمين في تلبية المتطلبات اللازمة لتدعيم رأسماله. 4- المصرف التي يصنف رأسماله (4) يشهد مشاكل حادة بسبب عدم كفاية رأس المال لتدعيم المخاطر الملازمة لمسارات الأعمال والعمليات المصرفية. حيث يكون لدى المصرف مستوى عالٍ من الخسائر في القروض المتعثرة والتي تتجاوز أكثر من نصف إجمالي رأسماله، كما يعاني المصرف من خسائر كبيرة في معاملاته المصرفية والعمليات الائتمانية، و/أو تحقيق نتائج سلبية في ربحيته. وبنـاءً على ما سبق فقد يعاني المصرف أو لا يعاني في تلبية المتطلبات التنظيمية، ولكن من الواضح عدم وجود كفاية في رأس المال. فإذا لم تتخذ الإدارة أو المساهمين إجراءً فورياً لتصحيح الاختلالات، فإنه يتوقع الإعسار الوشيك للمصرف. مما يتطلب وجود إشراف تنظيمي لضمان اتخاذ الإدارة والمساهمين الإجراءات المناسبة لتحسين كفاية رأس المال. 5- المصارف التي يصنف رأسمالها (5) تعتبر معسرة. بحيث تتطلب إشرافاً رقابياً قوياً لملافاة خسائر المودعين والدائنين، حيث أن خسائر الاستثمارات والعمليات المصرفية وعمليات الإقراض تقارب أو تتجاوز رأس المال الإجمالي، مع وجود احتمال ضئيل بأن تمنع إجراءات الإدارة والمساهمين من الانهيار الكلي للمصرف. ثانياً: جودة الأصول Assets Quality : تعتبر جودة الأصول ذات أهمية خاصة في نظام التقييم لأنها الجزء الحاسم في نشاط المصرف الذي يقود عملياته نحو تحقيق الإيرادات، لأن حيازة المصرف على أصول جيدة سوف يعني توليد دخل أكثر وتقييم أفضل لكل من السيولة والإدارة ولرأس المال. ويتم تصنيف جودة الأصول بالاستناد إلى دراسة القضايا التالية: 1- حجم وشدة الأصول المتعثرة بالنسبة لإجمالي رأس المال. 2- حجم واتجاهات آجال تسديد القروض التي فات موعد تسديدها، والإجراءات المتخذة لإعادة جدولتها. 3- التركزات الائتمانية الكبيرة ومخاطر المقترض الوحيد أو المقترضين ذوي العلاقة. 4- حجم ومعاملة الإدارة لقروض الموظفين. 5- فعالية إدارة محفظة القروض بالنظر إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والضوابط والتعليمات النافذة 6- النشاطات القانونية المتعلقة بالائتمان (مطالبات، ملاحقة المقترضين... الخ). 7- مستوى المخصصات المكونة لمواجهة خسائر القروض والائتمانات المتعثرة. 8- أساليب إدارة الأصول الأخرى مثل (الاستثمار بالأوراق المالية، الأصول الثابتة، والكمبيالات....الخ ثالثاً- جودة الإدارة Management Quality : حيث يتضمن هذا العنصر تحليل خمسة مؤشرات نوعية تتمثل أساساً في : الحوكمة , الموارد البشرية , الإجراءات , المراقبة , التدقيق ونظام المعلومات والتخطيط الاستراتيجي وبالتالي يتم تقييم جودة إدارة المصرف من خلال المعايير التالية [2] : - الحوكمة : حيث يتم تقييم عمل مجلس الإدارة على أساس تنوع الخبرة التقنية وقدرته على اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن الإدارة وذلك بفعالية ومرونة . - الموارد البشرية : ويشكل المعيار الثاني الذي يقيم ما إذا كانت مصلحة الموارد البشرية تقدم نصائح وتوجيهات وتؤثر بشكل واضح على المستخدمين , وذلك من خلال معيار التوظيف والتكوين , وكذلك نظام تحفيز العمال ونظام تقييم الأداء . - عملية المراقبة والتدقيق : حيث يتم تقييم دجة تشكيل العمليات الأساسية ومدى فعاليتها في تسيير المخاطر على مستوى المنظمة , وذلك من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية ونوعية المراجعة الداخلية والخارجية . - نظام المعلومات : والذي يقيم كفاءة وفعالية نظام المعلومات في توفير تقارير سنوية دقيقة وفي الوقت المناسب . - التخطيط الاستراتيجي : والذي يحدد ما إذا كانت المؤسسة قد طورت منهجاً متكاملا للتوقعات المالية قصيرة وطويلة الأجل , وما إذا كان مخطط التنمية قد تم تحديثه . رابعاً - إدارة الربحية Earning Management : تنظر إدارة المصرف إلى الأرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء المصرف، فهي تتأثر بشكل مباشر بمدى جودة الأصول، ويتم قياس فعاليتها من خلال تحديد نسبة العائد على متوسط الأصول كنقطة البداية لتقييم الأرباح وذلك بالإضافة إلى دراسة وتحليل العوامل التالية [3]: 1- مدى كفاية الأرباح لمواجهة الخسائر، وتدعيم كفاية رأس المال، ودفع حصص أرباح معقولة. 2- نوعية وتركيب عناصر الدخل الصافي بما في ذلك تأثير الضرائب. 3- حجم واتجاهات العناصر المختلفة للدخل الصافي. 4- مدى الاعتماد على البنود الاستثنائية أو عمليات الأوراق المالية، والأنشطة ذات المخاطر العالية أو المصادر غير التقليدية للدخل. 5- فعالية إعداد الموازنة والرقابة على بنود الدخل والنفقات. 6- كفاية المخصصات والاحتياطيات الخاصة بخسائر القروض. هذا وعادة ما يتم تحديد نسب الربحية لأغراض التصنيف بالاستناد إلى أداء المصارف الأدنى ذات الصفات المتشابهة، إلا أن التركيز عليها بمعزل عن العوامل الأخرى سيؤدي إلى نتائج مضللة، فعلى سبيل المثال: قد يعكس المصرف أرباحاً عالية جداً، لكن مصدر الأرباح قد يتأتى من حدث لمرة واحدة أو من نشاطات غير تقليدية (عالية المخاطر)، كما أنه بالرغم من ارتفاع نسبة الربحية، فإن الاحتفاظ بالأرباح يبقى غير كافٍ للسماح بنمو رأس المال والحفاظ على سير خطي نمو الأصول. خامساً - درجة السيولة Liquidity Position : تعتبر السيولة في المصرف من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها العملاء في المقارنة بين البنوك، حيث تمثل السيولة أهم وسائل وقاية المصرف من مخاطر الإفلاس من خلال قدرته على مواجهة الالتزامات التي تتميز بالدفع الفوري، وتمتاز البنوك بهذه الخاصية دون غيرها من المؤسسات لأنها لا تستطيع أن تؤجل صرف شيك مسحوب عليها، أو تأجيل تسديد وديعة مستحقة الدفع، كما أنها لا تستطيع مطالبة المدينين بسداد ما عليهم من قروض وتمويلات لم يحن آجال استحقاقها بعد، بالإضافة إلى ذلك يصعب توقع حجم وتوقيت حركة الأموال من وإلى المصرف، الأمر الذي يشكل صعوبة كبيرة أمام إدارة المصرف. ويمكن تعريف السيولة بشكل عام على أنها القدرة على تحويل الأصول إلى نقود بشكل سريع ودون تحقيق خسارة, أما السيولة في المصرف فيمكن تعريفها على أنها قدرة المصرف على الوفاء بسحوبات المودعين وتلبية احتياجات المتمولين في الوقت المناسب ودون الاضطرار إلى بيع أوراق مالية بخسائر كبيرة أو الاقتراض بفائدة مرتفعة. ويتم تحديد السيولة في أي مصرف من خلال العوامل التالية : 1- حجم ومصادر الأموال السائلة (الأصول سريعة التحويل إلى نقد) والمتاحة لتلبية التزامات المصرف اليومية. 2- مدى ملاءمة تواريخ استحقاق الأصول والخصوم. 3- مدى تقلب الودائع والطلب على القروض. 4- الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأوراق المالية وأثر ذلك على عائد المحفظة . 5- مدى الاعتماد على الإقراض ما بين المصارف لتلبية احتياجات السيولة. 6- مدى ملاءمة عمليات الإدارة للتخطيط والرقابة والإشراف (أنظمة المعلومات الإدارية). 7- الحالة الاقتصادية السائدة , فإذا كانت حالة انكماش فيفضل الاحتفاظ بدرجة عالية من السيولة , وذلك تخوفاً من عدم إمكانية تسديد الزبائن مستحقاتهم , وإما إذا كانت حلة رواج فإن الطلب على الأموال سيزداد وبالتالي يقوم المصرف بتمويل المؤسسات والأفراد الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كمية السيولة في المصرف . وتقاس نسبة السيولة بنسبة التوظيف إلى الودائع , أي مدى استخدام المصرف للودائع لتلبية احتياجات العملاء وهي نسبة التوظيف , وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة المصرف في تلبية القروض الإضافية ويفضل أن تقاس السيولة بنسبة الأصول السائلة وشبه السائلة إلى الودائع . سادساً - الحساسية تجاه مخاطر السوق Sensitivity to Market Risk : في ضوء التطورات المالية والمصرفية التي حدثت على المستوى الدولي، والتي جعلت المصارف أكثر عرضة للأزمـات المالية، فإنه لا بد من التركيز على العديد من الموضوعات في هذا الخصوص ومنها حساسية صافي أرباح المصرف للتوقعات المختلفة للتغير في أسعار الفائدة، والتقلبات في مراكز الصرف الأجنبي، وفي أسعار الأوراق المالية إلى جانب قياس ومتابعة العديد من المخاطر وأهمها : 1- مخاطر الائتمان : وهي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة الطرف المتعامل معه على الوفاء بالالتزامات في الوقت المحدد لها، وقد تؤدي إلى فشل البنك. ويمكن التقليل من هذه المخاطرة أو الحد منها من خلال مراقبة مجموع المبالغ التي يتم منحها كائتمان لعمليات التعامل بالعملات، ومبالغ الائتمان الممنوحة لعمليات السوق النقدي، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار مجموع المبالغ التي يمكن منحها لجهة واحدة، كما تظهر تلك المخاطر في حالة "عدم قدرة البنك على تكوين المخصصات الكافية لتجنيب تعرض أموال المودعين لخسائر محسوبة، وإظهار الدخل المحقق بصورة مغالى فيها نتيجة لعدم استبعاد الفوائد المهمشة 2- مخاطر السعر : هناك نوعان من الأسعار التي تؤثر على عمليات التعامل بالعملات الأجنبية، الأولى هي (أسعار الفائدة على العملات) حيث تؤثر على عمليات السوق النقدي خاصة عندما يكون آجال استحقاق عمليات الإقراض والاقتراض غير متطابقة، وتكمن هذه الخطورة في التغير العكسي المحتمل في أسعار الفوائد خلال فترة عدم التطابق سواء كان ذلك في المبالغ المقرضة أو المقترضة، أو تاريخ الحق المتعلق بكل منها. أما النوع الثاني فهو (أسعار الصرف) ويظهر واضحاً في التغيرات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وتكمن هذه المخاطر في نتيجة التغير العكسي المحتمل في أسعار الصرف لهذه العملات بسبب الاحتفاظ بأوضاع ومراكز عملات غير متلائمة إلى حد كبير. 3- مخاطر التسويق والتسييل : وهي المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على الحصول على الأموال السائلة عند الحاجة الضرورية لها نتيجة لعدم التطابق في التدفق النقدي لأجال عقود المقايضة أو التبديل للعملات، خاصة إذا كان بعض مراكز تلك العملات صعبة التسويق، أو كانت المبالغ المستحقة من عملة معينة في يوم معين كبيرة جداً مما يجعل من الصعب بيعها والحصول على العملات الأخرى المطلوبة، الأمر الذي يتطلب اقتراض مثل هذه العملات من السوق النقدي، وهو ما لا يتوفر في بعض الأحيان، وإذا توفر ذلك فقد تكون تكلفة الحصول على العملات المطلوبة عالية جداً هذا فضلاً عن عدم التماثل في آجال استحقاقات المراكز المحتفظ بها من العملات. في الختام اتمنى الفائدة للجميع والى اللقاء مع موضع جديد في عددنا القادم ان شاء الله مخلف سليمان ماجستير إدارة أعمال [1] - طارق عبد العال حماد – تقييم أداء البنوك التجارية " تحليل العائد والمخاطرة " – الدار الجامعية – الإسكندرية –مصر- ص 103 [2] - شوقي بو رقبة – طريقة CAMELS في تقييم أداء البنوك الإسلامية – جامعة الملك عبد العزيز – جدة السعودية – 2009 – ص 9 [3] - د علي عبد الله الشاهين - أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأمريكي (Camels) لدعم فعالية نظام التفتيش على البنوك التجارية (حالة دراسية على بنك فلسطين المحدود) – الجامعة الإسلامية – غزة – فلسطين -2005
- بواسطة المجلة
- January 12, 2026
مداخل تقييم أداء المحفظة
مداخل تقييم أداء المحفظة أن تقييم المحفظة يجب أن يتم من أن يتم من آن إلى آخر أثناء عملية إدارة المحفظة، حيث تتعدد مداخل تقييم أداء محفظة الأوراق المالية، وأهم تلك المداخل أربعة نماذج أساسية هي: 1- نموذج " شارب " sharp,s model 2- نموذج " ترينور " trynor,s performance measure 3- نموذج " جنسن " jensen,s performance measure 4- نموذج " فاما " fama,s compoment investment performance measure وسوف يتم عرض كل نموذج كما يلي: 1- نموذج sharp,s model وهو مقياس مركب لقياس أداء محفظة الأوراق المالية يقوم على أساس قياس العائد والخطر " المخاطر الكلية سواء المنتظمة وغير المنتظمة. والذي أطلق عليه المكافأة إلى نسبة التقلب في العائد the reward to variality، فذلك النموذج يحدد العائد الإضافي الذي تحققه الأوراق المالية نظير كل وحدة من وحدات المخاطر الكلية التي ينطوي عليها الاستثمار في المحفظة. ويستخدم وليام شارب الانحراف المعياري في قياس المخاطرة الكلية وذلك النموذج يستخدم في المقارنة بين المحافظ ذات الأهداف المتشابهة، وتخضع لقيود متماثلة. 2- نموذج ترينور trynor,s performance measure ويقوم ذلك النموذج على أساس الفصل بين المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة حيث يتم قياس المخاطر المنتظمة باستخدام معامل بيتا p ، ومعامل بيتا لمؤشر السوق دائماً يساوي واحد صحيح، ويقاس معامل بيتا عن طريق حساب التغاير covariance بين عائد محفظة ما وعائد محفظة السوق بمجموع حاصل ضرب انحرافات عائد المحفظة في انحرافات عائد السوق مقسوماً على عدد الفقرات مطروحاً منها درجة حرية واحدة. 3- نموذج " جنسن " jensen,s performance measure قدم " جنسن " نموذجاً لقياس أداء محفظة الأوراق المالية عرف بمعامل " ألفا "، وتقوم فكرة ذلك النموذج على إيجاد الفرق بين مقدارين للعائد فالمقدار الأول يعبر عن " مقدار العائد الإضافي "، أما المقدار الثاني ويعبر عن " علاوة خطر السوق" ومعامل ألفا يشير إلى الأداء للمحفظة يكون جيد لو كان المعامل موجب ويكون سيئاً لو كان المعامل سالباً. أما إذا كان ألفا صفراً فيشير ذلك إلى عائد التوازن حيث يتساوى عائد المحفظة مع عائد السوق ويعتمد ذلك المقياس على استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية capm كمعيار لتقييم أداء المحفظة من خلال المقارنة بين معدل العائد الفعلي المحقق ومعدل العائد المحسوب وفقاً لنموذج تسعير الرأسمالية. 4- نموذج " فاما " fama,s compoment investment performance measure وقد قدم " فاما " نموذجاً لتقييم أداء المحافظ يقوم على أساس المفاضلة بين المحافظ المتماثلة في مستويات المخاطرة. ويقوم ذلك النموذج على أساس التنبؤ بمنحنى السوق المتوقع ex-ant market line، وذلك المنحنى يوضح علاقة التوازن بين العائد المتوقع والخطر لأي محفظة. ويقوم ذلك النموذج على فرضية السوق الكاملة perfect market ويمكن تجزئة ذلك النموذج إلى ثلاث مكونات أساسية هي: I- تقييم الانتقائية evaluating selectivity II- تقييم التنويع evaluating diversification ج- تقييم الخطر evaluating risk 1-تقييم الانتقائية evaluating selectivity وهو يعبر عن مقياس لكيفية انتقاء واختيار المحفظة وذلك عن طريق عائد الإنتقائية، وذلك العائد هو الفرق بين المحفظة وعائد محفظة منوعة تنويعاً جيداً. 2-تقييم التنويع evaluating diversification وهو مقياس يقيس العائد المضاف نتيجة عملية التنويع، حيث أن عائد الانتقائية يمكن تقسيمه إلى نوعين من العائد هما: · العائد الناجم من الانتقائية net setectivity. · العائد الناجم عن التنويع diveritication. 1- تقييم الخطر evaluating risk وهو مقياس لخطر المحفظة، إذا فرض أن المستثمر يهدف إلى تحمل مستوى معين من الخطر في محفظة أوراقه المالية، فإن معامل بيتا في ذلك الافتراض فإن العائد الكلي الذي يعتبر تعويضاً عن مستوى الخطر يمكن قياسه كالآتي: الخطر = خطر المدير + خطر المستثمر.
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- January 12, 2026
أهمية المراجعة الادراية
أهمية المراجعة الادراية تتوقف اهمية المراجعة الادارية على ضرورة اقناع إدارة المنشأة بأن عدم نجاح بعض مشروعاتها يرجع إلى ضعف الكفاءة الادارية بها ، فيجب على الادارة أن تقنع بأن المراجعة الادارية ما هي إلا اداة تساعدها في اكتشاف المشاكل واقتراح الحلول اللازمة لعلاج تلك المشكلات . وبالتالي تتبع أهمية المراجعة الادارية من انها تساهم فيما يلي : - اكتشاف المشاكل التي قد لا يصادف المديرين اكتشافها او يتوافر لهم الوقت اللازم لمتابعتها واقتراح التوصيات الضرورية لمساهمة في حلها . تحقيق التناسق بين الاقسام المنختلفة داخل المنشأة واكتشاف المشاكل التي يصعب اكتشافها باتباع المراجعة التقليدية التأثير على القرارات الادارية التي تم التي تم اتخاذها إشباع الحاجات الادارية الى المعرفة واكتشاف اساليب وطرق افضل للاداء .هذا ويتأتى الطلب المتزايد على المعلومات الخاصة باداء المنشاة من مصارد عديدة مثل محللي الاستثمار الذين اعترفوا بان تقييم الادارة يعتبر ذات اهمية كبيرة في نفس الوقت من الصعوبة إتاحتها لاي طرف خارجي ، ويتطلب هذا ان تقدم الادارة مزيد من البيانات المرتبطة بادائها وبالمثل فإن المساهمين يعتبرون ان المراجعة الادارية اداة لخدمة الادارة وذلك من خلال ما يلي المساعدة في الضمان والتأكيد علة وجود محاسبة المسئولية ، حيث أن المراجعة الادارية ذات اسس وجذور تتبع مفهوم المساءلة المحاسبية ، والتي تتحقق عن طريق توفير المعلومات الى الاداة العليا نت اجل الحكم على اداة المرؤسين بالاضافة الى تقييم اداء الادارة العليا والحكم عليها. التمكن من تحديد الطرق والسبل الخاصة بتحسين العمليات حيث انه للمراجعة الادارية تقديم اقتراحات وتوصيات ملائمة تهدف الى تحسين اقتصاد وكفاءة وفعالية بجانب توفير حلول لتصحيح المشاكل المحددة . المصدر : مجلة المحاسب العربي
- بواسطة مدير التحرير
- January 12, 2026
تقييم الاداء في منظمات الاعمال
تقييم الاداء في منظمات الاعمال تعريف مفهوم الأداء: يوجد اختلاف بين فقهاء الإدارة في تفسير معنى الأداء فمنهم من يعتبر الأداء مسألة سلوكية ويقول البعض: " أن الأداء هو ما يقوم به الفرد ضمن حدود ودور معين يتم تحديده من قبل المنظمة أو المؤسسة لتحقيق أهداف معينه. أن الأداء هو " القياس بشيء ويؤكد هانابوس : أن الأداء هو القياس بشيء ما بطريقة معينه مع تحديد هدف معين لها". تقييم أو تقدير الأداء: تقدير الأداء هو العملية التي يجري من خلالها تقييم وتقدير تأدية الفرد لعمله. وذلك بالإجابة على سؤال أساس, " إلى أي مدى أجاد الموظف تأدية عمله خلال الفترة موضوع التقييم ؟ وهذا يمثل جزءاً واحداً فقط من إدارة الأداء وليس العملية بأسرها. فإدارة الأداء تشمل كذلك التخطيط, تشخيص المشكلات, تعيين معوقات الأداء, والعمل على تطوير مستوى الأفراد. لماذا يعتبر هذا التمييز هاماً؟ لأن التقدير وحده لن يحول دون وقوع المشكلات. كما يمكن تعريف مفهوم تقييم الأداء بأنه: الطريقة التي يتم من خلالها تقييم أداء الموظف في العمل (عامة من ناحية الجودة، والكمية، والتكلفة، والوقت). ويُعد تقييم الأداء جزءاً من التطوير الوظيفي. كما تُعد تقييمات الأداء تقارير نقدية منتظمة لأداء الموظفين داخل المنظمات أهداف تقييم الأداء، بصفة عامة، هي: توفير ملاحظات عن أداء الموظفين. التعرف على احتياجات الموظف للتدريب. توثيق المعايير المستخدمة في تحديد المكافآت التنظيمية. تشكيل أساساً للقرارات الشخصية: زيادة الرواتب، والترقيات، والإجراءات التأديبية، الخ. إتاحة الفرصة للتشخيص والتطوير التنظيمي. تسهيل الاتصال بين الموظفين والإدارة. التحقق من صحة تقنيات الاختيار وسياسات الوارد البشرية لتلبية متطلبات تكافؤ فرص العمل. أهمية عملية تقييم الأداء: تستهدف العملية إلى ثلاث غايات وهي على مستوى كل من المنظمة، المدير والفرد العامل التنفيذي. أهميتها على مستوى المنظمة: 1- إيجاد مناخ ملائم من الثقة والتعامل الأخلاقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوى العاملين اتجاه المنظمة. 2- رفع مستوى أداء العاملين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور. 3- تقييم برامج وسياسات إدارة الموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن أن تستخدم كمؤشرات لحكم على دقة هذه السياسات. 4- مساعدة المنظمة على وضع معدلات أداء معيارية دقيقة. * أهميتها على مستوى المديرين: 1- دفع المدرين والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم وامكانياتهم الفكرية وتعزيز قدراتهم الإبداعية للوصول إلى تقويم سليم وموضوعي لأداء تابعيهم. 2- دفع المديرين إلى تطوير العلاقات الجيدة مع المرؤوسين والتقرب إليهم للتعرف على المشاكل والصعوبات. * أهميتها على مستوى العاملين: 1- تجعل العامل أكثر شعور بالمسؤولية وذلك لزيادة شعوره بالعدالة وبان جميع جهوده المبذولة تأخذ بالحسبان من قبل المنظمة. 2- دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخلاص ليترقب فوزه باحترام وتقدير رؤساءه معنويا وماديا. معايير التقييم لكي يتمكن المسؤول المباشر عن الشركاء من إعداد تقارير أداء عن الشركاء بشكل موضوعي، فإن المعايير التالية يمكن أن يسترشد بها الرئيس المباشر لوضع التقدير المناسب عن الشريك. غير مرضي: تقصير واضح في أداء واجبات الوظيفه. وأمثلة ذلك ( نوعية إنتاجيته أقل من المستوى المطلوب – نتائج أعماله غير جيده – دائماً يؤخر الأعمال عن مواعيدها المقررة – عدم التفهم لأعمال الوظيفة رغم شرحها له . عدم الرغبة في تنمية أدائه- غير متحمس لأداء عمله. ليس لديه شعور بالمسئولية ). مرضي: أداؤه لعمله بشكل عام مرضي. وأمثلة ذلك ( يقوم غالباً بإنجاز المتطلبات الأساسية لوظيفته – ينجز العمل بشكل مقبول – ينقصه الحماس في عمله – يحتاج لتوجيه دائم - في حاجة ملحة لزيادة معارفه). جيد: على معرفة جيدة بنظم وإجراءات العمل. وأمثلة ذلك ( يتجاوب بسرعة مع متطلبات وظيفته – يقوم بمعالجة بعض الحالات ذات الأهمية – نتائج إنجازاته جيده). جيد جداً ( 4 ) : أداء ناجح للعمل، مرونة في التنفيذ مع قدرة على التعرف على المشاكل في مجال العمل. وأمثلة ذلك ( على علم كامل بمسئوليات وظيفته واختصاصات الإدارة التي يعمل بها – قادر على حل أغلب المشاكل بأسلوب جيد). جيد جداً ( 5 ) : القدرة على المبادرة في تطوير مجال العمل ووضع حلول للمشاكل التي تواجهه. وأمثلة ذلك ( مجهودات ذاتية تعني بتطوير أعمال الإدارة بشكل عام مع إمكانية القيام بمسئوليات أكبر). ممتاز: القدرة على الإبداع والإبتكار ومعدل فوق العادي في إنجاز العمل. وأمثلة ذلك ( إنجازاته بارزة على مستوى الإدارة – مثال للإنجاز المتفوق). هناك شكل آخر من أشكال تقييم الأداء يمكن الاستعانة به لتقييم فاعلية الشركاء وهو على النحو التالي: بيان معايير الأداء المعــدل 1. يكمل العمل في الوقت المحدد مطلقاً أحياناً عادة دائماً 1 2 3 4 2. يطبق عملياً المهارات والقدرات اللازمة لأداء العمل ليس بصفة ثابتة بصفة ثابتة دائماً 1 2 3 3. يطبق عملياً الإبداع وروح المبادرة مطلقاً أحياناً عادة دائماً 1 2 3 4 4. يفي أو يتجاوز أهداف التسويق المحددة لكل ربع ساعة من السنة يوجد مجال للتطور مرضي ممتاز 1 2 3 مشاكل عملية تقيم الأداء: يمكن تصنيف هذه المشاكل إلى مشاكل ذاتية تتعلق بالمسؤول عن عملية التقييم، وأخرى موضوعية تتعلق بعملية الأداء بحد ذاتها. 1- المشاكل الذاتية: تتعلق بما يلي: - خصائص وصفات المقوم: وترتبط هذه الصفات بمدى مهارة وخبرة المقوم لممارسته للمهنة؛ لذى يشترط في المقوم أن يكون ذا خبرة عالية والقدرة على التفاعل الاجتماعي. - التساهل والرفق: حيث يميل بعض المقومين إلى التعامل برفق مع المرؤوسين في هذه العملية وهذا يخفي النتائج الحقيقية للعملية، ويبعد عن الهدف المسطر. - تأثير الهالة: وهي الزاوية التي ينظر بها إلى المرؤوس فإذا كانت تلك النظرة إيجابية تكون نتائج التقييم إيجابية والعكس صحيح، وهذا ما يفقد قيمة معايير التقييم ويضفي جانب الحياد. - النزعة المركزية: وهو أن يميل المقيم إلى إعطاء أحكام متوسطة وعامة تجاه أداء الأفراد، وهذا يؤثر على الأحكام النهائية حول العملية لعدم تباين النتائج. - الأولية والحداثة: تظهر في عملية التقييم طويلة المدة حيث يتم بالأخذ الأولي لأداء الفرد دون النظر إلى التطورات اللاحقة لأول تقييم، أو يهمل أداء الفرد السابق ويعمد المقوم إلى إعطاء صورة عن أحدث مستوى للأداء، فهذا من شأنه أن يعدم خاصية الاستمرار لهذه العملية التي تستهدف عملية جمع التغيرات الماضية والحالية والمتوقعة في المستقبل. - التحيز الشخصي: وهو إنحياز الشخص المقوم لصالح الرد المراد تقييم أداءه بسبب القرابة أو الصداقة أوالجنس أو الموطن. 2- المشاكل الموضوعية: تتعلق بالعملية بحد ذاتها؛ وهي تتمثل فيما يلي: - عدم الوضوح في أهداف العملية يعطي نوع من العشوائية. - عدم دقة المعايير وعدم قدرتها على التعبير الحقيقي للأداء. - عدم وجود تعليمات سليمة وكافية في أسلوب التقييم.